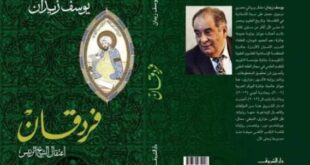تبدأ الكاتبة منى تاجو روايتها بتعريف الظلم الذي يقع على المرأة وعلى الرجل، وتتساءل هل الضرب أو الاغتصاب هما الظلم، أم أنَه يجتاز الجسد إلى النفس والروح؟ لقد ظلمت بطلة الرواية من التربية القاسية، ظلمت من أمِّ قاسية أرادت أن تبحث لابنتها عن زوج غني “دعونا نقول: لا يحمل الظلم صفة محدَدة، ولا ينحصر بجنس واحد، ولا بعمر محدد، إنَه فعل يقع على الجميع بأنواع وأشكال مختلفة، هل هو من طبيعة الحياة”.
تخرج الشخصية الرئيسية من بيتها، وفي طريقها تصل إلى صندوق البريد، كما تفعل كلَ يوم، وهناك تجد رسالتين، واحدة من صديقتها التي تراسلها دائما، وأخرى بلون أزرق فاتح، لا عنوان للمرسل ولا المرسل إليها، فكيف وصلت إلى الصندوق؟ ومن هنا تبدأ الحكاية.
تفتح الرسالة وتقرأ لتجد أنَ رجلاَ ما في عمر والدها، يعيش وحيداَ مثلها، إنَه يتبعها ويعرف أين تسكن، يقول لها: إن رغبتِ في أن نستمرَ، فاتركي رسالة تشعرني بذلك.
هذه الرسالة تشغل هذه المرأة، هناك من يراقبها ويريد التواصل معها، وهو في عمر والدها، ماذا يريد منها، وإلى أين يريد أن يصل؟ هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نتعرَف على حياتها، كيف تعيش في بيتها، ثمَ تجد رسالة أخرى، ويناديها بابنتي، ويطب منها أن يقبِل جبينها، لأنها بعمر أولاده.
تتساءل الكاتبة، كم اشتهيت واحدة دون أن أنالها، من هذا الداخل إلى عرينها، هل هو صديق، حبيب، مجنون، إنَه رجل مسن يعيش وحيداَ ويبحث عمَن يؤنس وحدته. وتتوالى الرسائل فتزيدها قلقاَ وتعاني من الصداع بسببها، لكنَنا نعرف كيف تفكِر وكيف تعيش، ثمَ نعرف من هذه الرسائل: أنَ الرجل لم يتزوَج، وكلُ الأصدقاء والأقرباء الذين هم من عمره قد رحلوا، صحته جيدة، وكان يعمل في الصناعة مثل أبيه، ومنذ طفولته عشق الخيوط الملونة والأنسجة، وعندما أصبح شاباَ، كبر العمل معه ولم يجد وقتاَ للزواج، وإنَه غير نادم، ويسألها هل هي متزوِجة؟ ويزيَل الرسالة بكلمة بابا، وهنا تتذكر حين أخذتها أمُها إلى خطوبة ابن الجيران، كان عمرها ثلاث عشرة سنة، وحين تهتم الأم بزينتها، تقول لها: أمي كم أنت جميلة، فتجيبها الأمُ، بأن لا تتحدث بما هو أكبر من عمرها، ومن المبكر على هذا الأمر أن تلاحظيه أو تتحدثي عنه. وتقول الكاتبة على لسان بطلتها: آلمتني كلماتها، لم أخطئ لم تقسين عليَ يا أمي؟ وحين تدعى إلى الرقص، تطلب إليها أن ترفض، وكانت العروس ابنة السادسة عشرة، الزينة على وجهها أكثر من زينة أمها، هي تكبرها بسنوات قليلة، هل ستخطب عندما تصل إلى عمرها، وهل سترتدي ثوباَ جميلاَ وتستمتع بزينة كاملة وتجتمع النسوة للاحتفال بها.
ثمَ تدعى إلى الرَقص، وترفض، وذلك لأنَ أمها تنظر إليها، تطلب منها أن تجلب لها كأس ماء من المطبخ، وهنا تلتقي بابن الجيران الذي يتحرَش بها ويدخلها إلى غرفته، ويطلب منها أن تجلس في حضنه ” كنت خائفة منه ومن أمِي، وأمر آخر كنت أجهله، حاول أن يضمني فصرخت وتملصت راحت أصابعه تنغرس في ذراعي، واقترب مني ليقبلني، عادت الرائحة الواخزة تصل أنفي، خالط خوفي تقزَز، بدأت أقاوم، حاولت التملص، لم أستطع، صرت أبكي، هدَدني، فعلا صراخي، حاول أن يسدَ فمي، عضضت يده، صرخ أيضاَ، فتح الباب وأطلت والدته “.
تأمره والدته بأن يترك الفتاة، وبأنه لن يكف عن انحرافاته، وإنَها سوف تشكوه إلى والده، ثمَ تأخذها إلى المطبخ وتغسل وجهها، وتهدئ من روعها وتعيد ترتيب شعرها وثيابها، وتقول لها: ألَا تحكي لأحد، لقد أراد أن يلعب معها، وحين تعود إلى أمِها، وتمسك بيدها المرتجفة، تستغرب، وتقول لابنتها، سنعود إلى البيت، وتخبرها الفتاة بما حصل بسبب كثرة الأسئلة من أمِها التي تمنعها من الخروج ثانية، وقد أثرت هذه القصة في حياتها، فهي لم تذنب، كانت الضحية، وبقيت الفتاة تحمل كلَ العمر الخوف من الرجال وتهاب أمَها، عقوبة في غير مكانها، وكبح رغبات بريئة تأتي من كوني أنمو حتى بعد أن أصبحت شابة.
تعتمد الكاتبة طريقة جديدة في القص الروائي، عن طريق الرسائل، ولكنها من طرف واحد إلى الآن، وخلالها نتعرَف على كونها تعمل موظفة ومن يشاركها في العمل، صفاء الأنثى التي تحمل عنها عناء الوظيفة، والشارع وما به من بشر وأشجار وعمارات، إنَها الآن تدخل وتمدُ يدها إلى الصندوق لتجد فيه رسالة جديدة، فيخبرها أنَه يود رؤيتها، ويضع لها رقم الهاتف، مخاطباَ إياها بكلمة (بابا) وينتظر أن تهاتفه مع قبلة على الجبين، وتتساءل إلى أين سيأخذها هذا الرجل؟ لقد حرَّك أعماقها، ولمس ما لم يصل إليه أحد، وتتذكر حكاية خطوبتها من ذلك الشاب الذي أحبته، هل يا ترى أحبته، وتتذكر ليلة الخطوبة، ارتدت ثوباَ زهرياَ بلون الحلم، وطوَّق إصبعها بالخاتم ليعلن خطوبتهما، وهي ترى أنَّه لم يكن ارتباطاَ وظلاَ محبوسين في الخاتم، لم تتألم سوى ألم سطحي وبقي لفترة طويلة.
ويكون الاتصال بالهاتف فيتبادلان الحوار، ويسألها إن كانت متزوِّجة، وهل يمكن أن يلتقيا في الحديقة، وعادت طاحونة الأفكار تدور وتدور معها ” هذا الرجل يعرف ما يريد ولن يتوقَّف حتى ينال ما يريد ” وتخاطب مرآتها لتقول لها: بأنَّها ليست خائفة منه وتذهب إلى لقائه وهي سعيدة، وفعلا تأتي إلى الحديقة، ويلتقيان، وتسأله عن اسمه، فيخبرها به، ثمَّ تكون زيارة المطعم، وتقارن بين زيارته وزيارة خطيبها السابق الذي انسحب بسبب ضغوط والدتها، ربَّما تزوَّجنا وأنجبنا أولاداَ، وتخاطبه باسمه، ” ألا تريدني بجانبك ” ويبدا الحديث عن طفولتها، ومدرستها وعائلتها وحبها الأوَّل، يغادران المطعم فتمسك بيده، تدخل إلى بيتها ” فتحت الخزانة حيث يقبع الصندوق المزيَّن بالأصداف، لم تسمح أمِّي لأحد أن يفتحه، فتجد فيه: إصبع قلم أحمر شفاه اشتريته، أخذته مني وقرَّعتني على شرائه، وهذه بلوزة مذهبة ألحت عليَّ إحدى الصديقات لأشتريها، أيضاَ قالت : لا يليق بالفتيات المهذبات أن يرتدينها، وكتاب “لا أنام” لإحسان عبد القدوس، وحين رأته تحت وسادتي، أخذته وقرَّعتني لأنني على وشك الانحراف، كم كنت قاسية يا أمي، ما أنا إلا شابة تريد أن تكون كقريناتها ونت تحرميني من كل ما تتمتع به الشابات، إلى أن أصبحت حتى صرت عجوزاَ قبل أواني”.
تستحضر ذكرياتها مع نبيل، خطيبها السابق وتعرف من الصندوق أنَّه كان يرسل لها من غربته الرسائل، وكانت أمَّها تخفيها عنها، واعتقدت أنَّه لا يسأل عليها، وتقف لتواجه أمَّها “حرمتني الشاب الذي أحبُّ، حرمتني أن أكون مراهقة وشابة، حرمتني الشاب الي أراد أن يتزوَّجني، أما كفاك؟ أحنُّ إلى طفلي أضمه إلى صدري وأرضعه من صدري، كفاك أما انتهيت”.
تتداعى الذكريات، بين نبيل وعبد الرؤوف، وتقارن بينهما، ربما تكون حاجتها إلى أب، إلى أخ، وربما تهرب من صقيع الواقع، ويعود إلى مخاطبتها باسم لبنى الغالية، وبانَّها ابنته ويهديها قبلة على الجبين, وتستنجد بصفاء، وتخبرها بهذه القصة، ويتمُّ القاء في بيتها مع صفاء، ويدور الحديث حوله الذي نسي أن يحبَّ وأن يتزوَّج، وقد أخذه والده إلى عمله وعمره ثماني سنوات، يعجب بالنول والحركات التي يراها، ثمَّ يتقرَّر سفره إلى إنكلترا للدراسة، كان العمال يعملون على النول اليدوي، وعندما عاد عمل على الكهرباء، وتكون الدعوة القادمة في بيته.
تقول الكاتبة: ” سيكون قاسياَ كلُّ ما يحيط بك، التقدم بالعمر، رحيل الأقرباء والأصدقاء، الشعور بأنَّ كلَّ ما يحيط بالإنسان يرحل بعيداَ، ألا تخافين من الوحدة ” ورداَ على سؤال لماذا لم تتزوَّجي، تجيب ” أصبحت أتردد وأمي تبرز عيوب الخاطبين من خوفها عليَّ، حتى أصبحت أخاف من الزواج، لقد ربيت على أن أخاف من الآخرين ” إلى أن جاءت الرسائل الزرقاء، فجعلتها تقبل التواصل معه، لقد ضعفت وكانت تطلب قرباَ إنسانياَ.
لقد انتهى الأمر بأن تحبه ويحبها، ويكون الزواج وتحضر صفاء وأمُّها العرس “لقد سمحت للنور أن يتدفق غامراَ إلى داخلي وأضأت داخلي، لا تغادر حياتي، فقط لا تبتعد عني”.
هذه قصة لبنى، كانت تقصها على الكاتبة، وكانت مريضة بالورم الخبيث، جاء زوجها إليها لينشر الخبر، لكن لبنى لم تمت، وقد أخذت العلاج وها هي تشرب القهوة التي أعدتها لبنى، هما لوحة جديدة للحب والوفاء الزوجي.
الشخصيات عددها قليل، استطاعت الكاتبة أن تقوم بكلِّ هذا العمل الضخم وتنسج رواية من 383 صفحة بالتمام والكمال، وهذه الشخصيات نهضت بالعمل واستطاعت أن تقوم بدورها الذي حمل الهمَّ الإنساني بكلِّ أشكاله وأصنافه، لقد اعتمدت الرواية على معايير ثابتة، معيارها دائماَ هو الحق والجمال، قد ظلمت لبنى من ناحية أمها، وهذا نتيجة جهل تربت عليه، فالرجل في مجتمعنا هو الذئب والفتاة هي حمل وديع ينتظر الجريمة التي ستقع، ويمكن القول: أن كلُّ فتاة بأبيها معجبة، ورغم الأحداث فقد وقعت في الحب ومن ثمَّ الزواج.
عذراَ أمي … أنا أحب: رواية، منى تاجو.
دار استنبولي للنشر والتوزيع.
عدد الصفحات: 386.
منى تاجو، صيدلانية ولدت وعاشت في حلب، أصدرت ثلاث روايات حتى الآن.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.