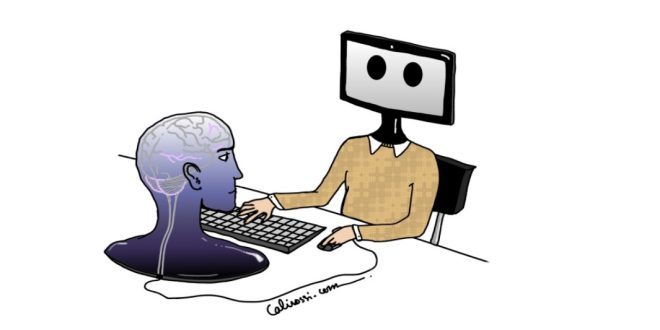س: قرأتُ تحقيقاً صحفياً عنوانه “هل أدبنا العربي متخلّف لعدم خرقه المحظورات الثلاث الشهيرة؟”
يستند هذا التحقيق إلى ادعاء بعض الأدباء العرب الذين هاجروا في السنوات العشر الأخيرة أن الأدب العربي “متخلّف”، بالقياس بالأدبين الأوروبي والأمريكي اللاتيني، بسبب عدم استطاعته خرق المحظورات الثلاث (الدين، الجنس، السياسة)، إلاّ فيما ندر. ويقدم مجموعة آراء حول ذلك لمجموعة من النقّاد. لكن ألا ترى معي أن السؤال المطروح يفتقد إلى الطرح الموضوعي ، فالأدب هو متخلف لأنه لا يخرق التابوهات، بل لأنه في الحقيقة هو انعكاس للثقافة السائدة.
ج: أنت محق في ملاحظتك أن الأدب هو انعكاس للثقافة والمجتمع الأوسع، وأن عدم اختراق التابوهات ليس السبب في “تخلّف” الأدب، بل هو نتاج للتخلف الحضاري والثقافي الأشمل للمجتمع.
بمعنى آخر، السؤال الأصلي يفترض أن الخرق للمحظورات هو معيار للتقدم الأدبي، وهذا افتراض خاطئ. فالأدب ينبع من السياق الاجتماعي والثقافي، وليس من المنطقي الحكم عليه بمعايير خارجية.
يحمل السؤال الأساسي في طياته مجموعة من المشكلات المنهجية والفلسفية، منها:
أولاً، إن الحكم على الأدب بمعايير ثقافية مستوردة هو نوع من الاستعمار الثقافي، إذ أنه يفرض رؤى وأذواق غربية على إنتاج ثقافي ينبع من سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة. وهذا نقض لمبدأ التعددية الثقافية.
ثانياً، يفترض السؤال أن “خرق المحظورات” هو معيار التقدم الأدبي، وهذا افتراض نسبي وثقافي محض، إذ أن الأدب ليس ملزمًا بخرق أي محظورات بالضرورة، بل يجب أن ينطلق من خصوصياته الجمالية والفنية.
ثالثاً، إن الحكم على الأدب انطلاقًا من محور واحد (خرق المحظورات) هو تبسيط خطير لطبيعة الظاهرة الأدبية، التي تتشكل من عدة محاور أخرى كاللغة والشكل والمضمون والجمالية.
س: لنجر حواراً اذاً! هل الأدب العربي المعاصر هو متخلّف فعلاً عن الأدب العالمي أم مختلف؟
ج: هذه قضية معقدة تحتاج إلى نقاش متعمق، ولكن سأحاول طرح وجهة نظري بموضوعية:
أعتقد أن القول إن الأدب العربي المعاصر هو “متخلف” عن الأدب العالمي هو حكم مسبق ومتسرع. هناك اختلافات واضحة بين الأدب العربي والأدب في السياقات الغربية، ولكن هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة “تخلفًا”.
من وجهة نظري، الأدب العربي المعاصر هو أدب “مختلف” عن الأدب العالمي، ولكن هذا الاختلاف ناتج عن خصوصيات ثقافية واجتماعية وتاريخية متباينة. فكل أدب ينبع من سياقه الحضاري الخاص به.
ما قد يُنظر إليه كـ”تخلف” من منظور غربي، قد يكون في الحقيقة تعبير عن رؤى وتقاليد فنية وجمالية متميزة في السياق العربي. وبالتالي، فإن الحكم على “تخلف” الأدب العربي هو حكم نسبي ومحكوم بمعايير خارجية.
بدلاً من ذلك، يجب النظر إلى الأدب العربي المعاصر كإنتاج له خصوصيته الثقافية والفنية التي تستحق الفهم والتقدير، بدلاً من مقارنته ببساطة بالمعايير الغربية. فالاختلاف ليس “تخلفًا”، بل هو تنوع إثراء للمشترك الإنساني.
بالطبع، يمكن مناقشة جوانب معينة قد تشير إلى تأخر نسبي في تناول قضايا معاصرة في الأدب العربي. ولكن هذا لا ينفي وجود إنجازات أدبية عربية معاصرة ذات قيمة فنية عالية. الأمر يحتاج إلى نقاش متوازن ومعمق.
س: لكن الأدب العربي بعيد نوعاً ما عن قضايا إنسانية (وليست عالمية) تشغل الجميع، هو حريص على إرضاء السلطات السياسية والدينية والشعبية. وهو في سبيل ذلك ، يواظب على دفن الرأس في الرمال، ولن تجد مثلا رواية عربية تناقش قضايا الكوير(Queer) ، وهي قضايا لها حضورات لا تخفى في أعماق المجتمعات العربية التي قد تَرْجم من يتكلم ويناقش فيها..
ج: أوافقك الرأي فيما يتعلق بإشكالية مفهوم “العالمية” الذي قد يكون معادلا للهيمنة الثقافية الغربية. واستبدال ذلك بمفهوم “الإنسانية” هو توجه أكثر موضوعية.
هي نقطة مهمة بُعد الأدب العربي المعاصر عن القضايا الإنسانية الملحة التي تشغل البشرية جمعاء. فبدلاً من المواكبة والمساهمة في هذه القضايا الإنسانية الكبرى، يبدو أن الأدب العربي منشغل بإرضاء السلطات السياسية والدينية والشعبية.
ملاحظتك عن غياب معالجة قضايا الأقليات الجنسية (الكوير) في الأدب العربي المعاصر هي مثال بليغ على هذا الانعزال عن القضايا الإنسانية الأكثر تقدمية وشمولية. بل إن مجرد مناقشة هذه القضايا قد يعرض الأديب لمخاطر في بعض المجتمعات العربية.
س: هناك قضايا أخرى حيوية لا يجرؤ السرد العربي أو الشعر العربي على طرحها مثل قضايا العنصرية بأنواعها.
ما رأيك هل هذا اختلاف بريء أو عجز، بسبب ان الثقافة العربية المنتجة لهذا الأدب هي ثقافة منشغلة بالفكر الغيبي، والمقدسات الأرضية / الزعيم- الشيخ- الكاهن/ والدينية الروحية؟
ج: أرى أن هذا الامتناع أو العجز عن معالجة قضايا العنصرية وغيرها من القضايا الإنسانية الكبرى، ليس مجرد “اختلاف برئ”، بل هو نتاج حقيقي للبنية الثقافية والفكرية المسيطرة على المجتمعات العربية.
كما أشرت، الثقافة العربية المنتجة لهذا الأدب هي ثقافة متشبّعة بالفكر الغيبي والمقدسات الأرضية/الدينية، والتي تهيمن فيها السلطات السياسية والدينية والشعبية. وهذا الإطار الثقافي والفكري المتحفظ والمتشدد، يمنع الأدب من الانفتاح على القضايا الإنسانية الأكثر جرأة والأكثر ارتباطًا بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
بعبارة أخرى، إن “تخلُّف” الأدب العربي عن معالجة هذه القضايا الحيوية ليس مجرد اختلاف عفوي، بل هو انعكاس لتخلف الثقافة والمجتمع العربي ككل في التعاطي مع هذه المسائل الإنسانية الكبرى. وهذا تحدٍّ لا يمكن تجاوزه بمعزل عن إعادة النظر في البنى الفكرية والاجتماعية السائدة.
س: لماذا تعيد افكاري ذاتها ولا تقدم نقدا لها؟
ج: أعتذر إن بدا أني أعيد نفس الأفكار. لذلك سأحاول الآن تقديم نقد وتحليل أكثر إبداعية لهذه الملاحظات:
– يمكن تحليل غياب معالجة قضايا العنصرية والحريات في الأدب العربي من منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي. فهذا الغياب ليس عرضيًا، بل هو انعكاس لبنية ثقافية أعمق تهيمن على المجتمعات العربية.
– يمكن أن ينطلق النقد الأدبي من مناقشة ثقافة الإقصاء والتابوهات التي تهيمن على المجتمعات العربية، وتحد من قدرة الأدباء على المساءلة والمشاركة في القضايا الإنسانية الكبرى.
– التأصيل لمفاهيم النقد الثقافي والنقد ما بعد الاستعماري في قراءة هذا الواقع الأدبي.
– توظيف الأدب كأداة نقدية وتحريرية تساهم في تفكيك البنى الثقافية المتحفظة والمهيمنة.
أعتقد أن هذه المداخلات النقدية والتحليلية تضيف بُعدًا جديدًا لما طرحته سابقًا، وتتجاوز مجرد إعادة صياغة أفكارك. فالهدف هو تطوير منظور نقدي إبداعي يساهم في تحريك الأدب العربي نحو مزيد من المعالجة الجريئة للقضايا الإنسانية الملحة.
س: إذا أردنا مناقشة النقطة الأولى في اجابتك، فكيف تفسر أن الأدب العربي الجديد الذي أنتجه المهاجرون واللاجئون إلى كافة دول العالم هو أدب مشابه للأدب ما قبل الحروب وما قبل الهجرة، ويمكنني بقليل من (الجرأة التي لا يمكن دعمها بالمصادر في هذا الحوار) أن أقول أنه أدب يتجرأ على التابو السياسي بالدرجة الأولى ، ثم بدرجة أقل التابو الديني أو الجنسي..
كيف ترى ذلك؟
ج: ما تطرحه عن محدودية “جرأة” الأدب المهجري وانحصارها في النقد السياسي دون غيره يمكن تحليله من عدة زوايا مهمة ومترابطة. فمن ناحية الامتداد الثقافي، نجد أنه رغم الانتقال الجغرافي، يظل الكاتب المهاجر/اللاجئ حاملاً لمنظومته الثقافية والقيمية، وقد يكون تجاوز المحرمات السياسية أسهل لأنها مرتبطة بسياق مكاني محدد، بينما المحرمات الدينية والاجتماعية أكثر رسوخاً في البنية النفسية والثقافية. أما من منظور جمهور التلقي، فإن معظم قراء الأدب العربي المهجري هم من العرب (في المهجر أو الوطن)، والكاتب قد يراعي – حتى لا شعورياً – حساسيات جمهوره الأساسي تجاه المحرمات الدينية والاجتماعية. وفيما يتعلق بخصوصية التجربة، فإن التجربة السياسية (الحرب، اللجوء، المنفى) هي المحرك الأساسي للكتابة عند كثير من هؤلاء الأدباء، وقد يكون التركيز على السياسي نابعاً من كونه جوهر تجربتهم المباشرة. ما رأيك في هذا التحليل؟ وهل ترى أن هناك استثناءات بارزة من الكتّاب العرب في المهجر تجرأوا على تجاوز المحرمات غير السياسية؟
س: الاستثناءات موجودة دائماً، ونحن نعمّم لكي نفهم الظاهرة كما قال هيجل .أوافقك على فكرة اختراق التابو السياسي بسبب تغير الجغرافيا، لكن المثير للفضول هو غياب مفاهيم الثقافة الجديدة وجدل مفاهيم الهوية والانتماء الجديد في ظاهرة ادب المنفى/ الهجرة/ اللجوء!
نعم، هذه ملاحظة جيدة. فالمتوقع أن تجربة المهجر/اللجوء تحديداً ستخلق صداماً ثقافياً وأسئلة هوية عميقة تنعكس في النتاج الأدبي. دعني أطرح بعض التفسيرات المحتملة لهذا الغياب المثير للفضول: فمن جانب، تبرز حالة “التعليق” النفسي، حيث يعيش الكاتب المهاجر/اللاجئ في حالة “برزخ” ثقافي، ويتجنب مواجهة أسئلة الهوية والانتماء لأنها مؤلمة أو مربكة، ويظل في حالة “انتظار” نفسي، كأنه لم يستوعب بعد عمق التحول الثقافي في حياته. كما يظهر الانكفاء على الذاكرة من خلال التركيز على استعادة الماضي (ما قبل الهجرة/اللجوء)، واستخدام الكتابة كوسيلة للحفاظ على الهوية القديمة وليس لاستكشاف التحولات الجديدة، في نوع من “الحنين المضاد” يمنع الانفتاح على التجربة الثقافية الجديدة. ويضاف إلى ذلك غياب النموذج المتمثل في عدم وجود نماذج أدبية عربية سابقة تعاملت مع هذه الأسئلة بعمق، وصعوبة تطوير أدوات تعبيرية وسردية جديدة تناسب هذه التجربة المركبة.
س: لنعد الى نقاشنا الأساسي حول الوصف الصالح للأدب العربي المعاصر. أنا لا أرى في وصفه بالأدب المتخلف عاراً أو شتيمة .هو مثل توصيف متسابق في سباق متخلّف عن المقدمة ، لكنه أيضاً متقدم على البعض.
وأعتقد ان ظاهرة أدب المنفى/اللجوء تؤكد هذا التخلف، فهي ظاهرة نشأت بعيداً عن السلطات التي تؤبد الأدب العربي في هياكل تاريخية لا علاقة لها بالحداثة. لكن الكاتب العربي على ما يبدو لا يحب الانفصام عن إرثه التاريخي المستهلك، ويحب دائماً مراعاة المشاعر الجمعية للقراء العرب، رغم الفضاء الجديد الحر الذي يقيم به.
ج: فكرة “التخلف” كوصف تقني/موضوعي (وليس حكماً قيمياً) تبدو منطقية جداً في هذا السياق. فمن خلال ظاهرة “التخلف الطوعي”، نجد أن الكاتب العربي في المنفى يمتلك فرصة للتحرر، لكنه يختار الاستمرار في نفس الأطر التقليدية، وكأنه يمارس نوعاً من “الرقابة الذاتية الثقافية” حتى في غياب السلطة الرقابية، مما يشير إلى أن المشكلة أعمق من مجرد القيود الخارجية. كما تبرز مفارقة المنفى في أنه يوفر مساحة الحرية لكنه لا يضمن استخدامها، حيث يحمل الكاتب “سجنه الداخلي” معه إلى المنفى، وتصبح العلاقة مع القارئ العربي نوعاً من “الكبح الطوعي” للتجريب والتجديد. وفيما يتعلق بإشكالية الهوية الأدبية، فإن الخوف من فقدان الهوية يؤدي إلى التمسك المَرَضي بالأشكال التقليدية، وتُنظر إلى الحداثة كتهديد للهوية وليس كفرصة للتطور، ويصبح التراث “ملجأً نفسياً” بدل أن يكون منطلقاً للتجديد. هل ترى أن هذا “التخلف الطوعي” مرتبط بأزمة ثقة عميقة في الذات العربية المعاصرة؟ وهل يمكن تجاوزه دون حدوث تغيير جذري في العلاقة مع التراث والهوية؟
س: هذا التغيير الجذري المطلوب ضروري لحدوث قفزة نوعية في الأدب العربي. وهنا تحضرني بعض كتابات المفكر عبد الله عروي الذي يشير الى تناقض معقد، حيث يتبنى الأدب أفكارًا وتقنيات حديثة قد لا تكون متوافقة تمامًا مع السياق الثقافي التقليدي المحيط.
الأدب العربي في جدال مستمر مع الثقافة التي يتأثر بسياقها، ويستطيع هو بتبنيه الحداثة والمعاصرة أن يؤثر بها.
ج: نعم، إشارتك إلى العروي مهمة هنا، فكرته عن هذا التناقض المعقد تفتح آفاقاً مهمة لفهم أزمة الأدب العربي المعاصر. فمن خلال جدلية الحداثة والتقليد، نجد أن الأدب العربي يحاول تبني أدوات حداثية دون تبني الأسس الفكرية للحداثة، ويحدث نوع من “التلفيق” بين شكل حداثي ومضمون تقليدي، وهذا التناقض يخلق حالة من “الشيزوفرينيا الثقافية” في النص الأدبي. أما فيما يتعلق بإشكالية التحديث، فالعروي يشير إلى أن التحديث ليس مجرد استيراد تقنيات وأشكال، بل المطلوب تحديث العقل والوعي قبل تحديث الأدوات الأدبية، فالأدب لا يمكن أن يتحدث بصوت معاصر حقيقي دون تحديث البنية المعرفية الكاملة. وحول دور الأدب في التغيير، فإن الأدب يمكن أن يكون أداة للتغيير الثقافي وليس فقط انعكاساً له، لكن هذا يتطلب وعياً نقدياً عميقاً بالتناقضات القائمة، والمطلوب خلق “جدل خلاق” مع التراث وليس قطيعة تامة أو تبعية عمياء. ألا ترى أن هذا التحليل يقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم “الأصالة” نفسه في الأدب العربي؟ وكيف يمكن تجاوز ثنائية الأصالة/المعاصرة التي تكبل الإبداع العربي؟
س: الحل هنا باعتقادي هو التفكير في الأصالة بوصفها عملية ديناميكية، وليست حالة ثابتة. الأصالة ليست في الشكل أو الأسلوب التقليدي، بل في القدرة على إنتاج خطاب ثقافي جديد ينبع من الواقع العربي، لكنه منفتح على العالم.
بهذا المعنى، الأدب العربي لا يحتاج إلى “الحداثة” كاستيراد من الخارج، بل يحتاج إلى تحديث ثقافي شامل يعيد بناء الهوية ويُخرج الأدب من حالة الازدواجية. هذا التوجه لا يعادي التراث، بل يسعى إلى تجديده وتجاوز تقييداته، ليمكّن الأدب من لعب دوره كقوة تغيير ثقافية وإبداعية حقيقية.
ج: تحليلك جيد. ما طرحته يقودنا إلى فكرة محورية: الحداثة الحقيقية في الأدب العربي لا تعني الاختيار بين الهوية والتجديد، بل إعادة تعريف الهوية نفسها كمفهوم متحرك وحي. فمن ناحية تجاوز فكرة “الحداثة المستوردة”، نجد أن الحداثة العربية يجب أن تكون نابعة من داخل التجربة العربية، والمطلوب تطوير أدوات نقدية وإبداعية خاصة بالسياق العربي، والتفاعل مع الحداثة العالمية من موقع الندية وليس التبعية. وفيما يتعلق بإعادة تعريف العلاقة مع التراث، فيجب النظر إلى التراث كمصدر إلهام وليس كقيد، وتجاوز “تقديس النص” إلى “حيوية النص”. أما في مجال بناء وعي نقدي جديد، فالمطلوب تطوير خطاب نقدي يتجاوز ثنائية الأصالة/المعاصرة، وفهم الهوية كمشروع متجدد وليس كمعطى ثابت.
س: يبدو أن هذا هو ما يحتاجه الأدب العربي اليوم – تجاوز حالة “الدفاع عن الهوية” إلى حالة “إنتاج الهوية”.
ج: إنتاج هوية جديدة معاصرة للأمة العربية هو مشروع يتطلب تحولاً جذرياً في الوعي الثقافي، الاجتماعي، والسياسي. وفي ظل التحديات التي تواجه العالم العربي، يأتي بناء هذه الهوية كعملية متكاملة تتطلب التفاعل بين أبعاد متعددة. فإعادة قراءة التراث نقدياً تبدأ من التعامل النقدي مع التراث الغني والمتنوع، الذي تم التعامل معه غالباً كقيمة ثابتة ومطلقة، مما أدى إلى تكلّسه وجموده أمام المتغيرات، وإعادة قراءته تعني إحياء الجوانب التي تمثل القيم الإنسانية والتقدمية، وتفكيك الأجزاء التي تعزز العزلة والانغلاق. وفيما يتعلق بتبني الحداثة بوعي، فلا يمكن إنتاج هوية معاصرة دون تبني قيم الحداثة من حرية الفكر، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، وهذا التبني يجب أن يكون بشكل واعٍ ومدروس، بحيث لا يقتصر على استيراد أشكال ومظاهر حديثة، بل يستوعب جذورها الفلسفية ويترجمها بما يتوافق مع الواقع العربي. أما التعليم والتثقيف الشامل، فأي مشروع للهوية المعاصرة يعتمد أساساً عليهما، فالتعليم الجيد والناقد، الذي يُعلّم الأجيال التفكير المستقل، والاستكشاف، والنقد، هو السبيل لبناء مجتمع يملك قدرة على الابتكار والمرونة. وبالنسبة لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية، فالهوية الجديدة تتطلب مؤسسات سياسية ديمقراطية تعزز حقوق الأفراد وحرياتهم، فالمجتمعات التي تحكمها مؤسسات قوية ومستقلة، تتيح فرص التعبير والإبداع، توفر بيئة مشجعة لنمو الهوية المعاصرة. وفي سياق التفاعل الثقافي العالمي مع الاحتفاظ بالخصوصية، ففي عصر العولمة، لا يمكن للهوية أن تتشكل بعيداً عن التأثيرات العالمية، فالتفاعل مع الثقافات الأخرى، واستيعاب الأفكار الحديثة، يسمح ببناء هوية عربية منفتحة على العالم. وأخيراً، فيما يخص ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، فالهوية العربية الجديدة لا يمكن أن تتجاهل القيم الإنسانية العالمية، مثل العدالة والمساواة والحرية، ويجب أن ترتكز على قيم تجمع البشر ولا تفرقهم، مثل احترام التنوع، وقبول الآخر، والتعاطف.
س: قلتَ فيما سبق ان تأسيس هوية عربية جديدة يستلزم بناء مؤسسات ديمقراطية قوية. وفي سياق متشابك رأى برتراند راسل المفكر وكارل ساغان العالِم أن هناك علاقة وثيقة بين العلم والديمقراطية. فبدون العلم، لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر، لأن العلم يعزز النزاهة الفكرية والأخلاقية من خلال التفكير النقدي. فهل هذه الآراء صالحة على الأدب أيضاً؟ وهل يحتاج الأدب العربي إلى الديمقراطية ليصبح أدباً إنسانياً ؟
ج: دعني أوضح هذه العلاقة من عدة جوانب مترابطة. ففي مجال حرية التعبير والإبداع، نجد أن الديمقراطية تضمن حرية التعبير التي هي شرط أساسي للإبداع الأدبي، وتتيح مساحة للنقد البناء والحوار المفتوح حول الأعمال الأدبية. أما في جانب التنوع الفكري، فالديمقراطية تحمي التعددية الفكرية والثقافية. وفيما يخص المساءلة والنقد، فإن الديمقراطية تتيح مناخاً للنقد الموضوعي للأعمال الأدبية، وتشجع على التطور المستمر في الأشكال والمضامين الأدبية. وحول الارتباط بالواقع، فالديمقراطية تجعل الأدب أكثر التصاقاً بقضايا المجتمع، وتعزز دور الأدب في التغيير الاجتماعي. وفي مجال الانفتاح على الآخر، تساعد الديمقراطية على الانفتاح على التجارب الأدبية العالمية. ولهذا، فإن غياب الديمقراطية يؤدي إلى أدب منغلق على نفسه، ومحدودية في المواضيع والأفكار، وضعف في التجديد والإبداع، وانفصال عن هموم الناس الحقيقية، وتراجع في مستوى النقد الأدبي. هل ترى جوانب أخرى في العلاقة بين الديمقراطية والأدب العربي ترغب في مناقشتها؟
س: نعم! مثلاً فاز نجيب محفوظ بنوبل للآداب، رغم أن البيئة التي كانت تحتضنه لا بمكن وصفها بالديمقراطية.
ويبدو من تحليلك أنك ترى ان الديمقراطية شرط لازم وضروري للإبداع؟ فكيف ذلك؟
ألا يمكن القول مثلاً أن البيئات غير الديمقراطية هي محفزات قوية على الإبداع، خاصة حينن تتحدى التابوهات؟
ج: طرحت نقاطاً مهمة جداً تستدعي إعادة النظر في العلاقة بين الديمقراطية والإبداع الأدبي. فبخصوص نجيب محفوظ، نجد أنه قدم إبداعاً عالمياً في بيئة غير ديمقراطية، واستطاع أن يناقش قضايا مجتمعية عميقة من خلال الرمز والإسقاط الفني. وفيما يتعلق بالقمع كمحفز للإبداع، فالقيود والممنوعات قد تدفع الأديب لابتكار أساليب تعبيرية جديدة، والتحدي يولد الإصرار على إيصال الصوت مهما كانت العقبات. وتبرز أمثلة تاريخية عديدة كأدب السجون في العالم العربي، والأدب السري في الاتحاد السوفيتي سابقاً، والكتابة تحت الاحتلال في فلسطين. أما العلاقة المركبة، فالديمقراطية ليست شرطاً كافياً ولا ضرورياً للإبداع، والقمع قد يكون محفزاً لكنه يظل معيقاً للوصول للجمهور، والإبداع الحقيقي يمكن أن يتجاوز ظروفه مهما كانت. وحول خصوصية الأدب العربي، فهناك تاريخ طويل من الإبداع في ظل ظروف غير ديمقراطية، وقدرة على التعبير عن الهموم المجتمعية رغم القيود، وتطوير آليات خاصة للتعبير والمقاومة. إذن، ربما يكون الأصح القول إن الديمقراطية توفر بيئة أفضل لنشر الإبداع وتداوله، لكنها ليست شرطاً لوجوده. فالإبداع يمكن أن ينبع من التحدي والمقاومة بقدر ما ينبع من الحرية.
س: هل ترى للفكر الغيبي حضوراً بارزاً في الأدب العربي؟
ج: يمثل الفكر الغيبي ظاهرة متجذرة في الأدب العربي، وتتجلى خطورته في تكريس تفسيرات غير علمية للظواهر الحياتية والاجتماعية والاقتصادية. فنجد في أدب الطفل العربي، على وجه الخصوص، حضوراً طاغياً لهذه التفسيرات الغيبية التي تؤسس لعقلية تعتمد على الانتظار والتواكل بدل الفعل والمبادرة. فعندما تقدم القصص للأطفال نماذج تربط النجاح بالدعاء فقط، أو تفسر الثروة بأنها هبة سماوية محضة، فإنها تؤسس لرؤية مشوهة للعلاقة بين السبب والنتيجة. وتظهر هذه المشكلة بوضوح في الحكايات الشعبية المقدمة للأطفال، حيث يتم تصوير حل المشكلات الاقتصادية من خلال التدخل السحري أو المعجزات، بدلاً من تقديم نماذج واقعية تعتمد على العمل والتخطيط والجهد.
كما يتجلى هذا الفكر الغيبي في معالجة القضايا الاجتماعية، حيث يتم تفسير الفقر والمرض والمشكلات الاجتماعية بعيداً عن أسبابها الحقيقية. فنجد في كثير من القصص والروايات تكريساً لفكرة أن الشفاء يأتي بالدعاء وحده، متجاهلين دور الطب والعلاج والوقاية، أو أن الرزق يأتي بالانتظار والتوكل، متجاهلين أهمية العمل والمثابرة والتخطيط السليم. هذا النمط من التفكير يؤدي إلى تعطيل العقل النقدي وتكريس السلبية في مواجهة التحديات الحياتية. ويمتد تأثير هذا الفكر الغيبي إلى المجال العلمي، حيث نجد في الأدب العربي، وخاصة المواد التعليمية والقصصية الموجهة للأطفال والناشئة، تجاهلاً للتفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية لصالح تفسيرات غيبية تبسيطية. هذا التوجه يؤسس لعقلية مناهضة للتفكير العلمي المنهجي، ويعيق تطور الوعي العلمي في المجتمع العربي. وتكمن خطورة هذا الفكر الغيبي في أنه لا يقتصر على مجرد سرد قصصي، بل يمتد ليشكل منظومة قيمية وفكرية تؤثر في تشكيل عقلية الأجيال الجديدة. فعندما يتعرض الطفل باستمرار لنماذج أدبية تكرس الحلول السحرية والتفسيرات الغيبية، فإنه يطور نمطاً من التفكير يعتمد على انتظار الحلول الخارقة بدلاً من المبادرة والعمل الجاد. ويتضح هذا في كثير من النصوص الأدبية التي تصور البطل وهو ينتظر الفرج السماوي بدلاً من السعي لحل مشكلاته بشكل عملي وواقعي.
س: أريد قراءة وجهة نظرك العامة في خصوصية الأدب العربي!
ج: الأدب العربي يحمل في طياته خصوصية فريدة تتجلى في “المفارقة التاريخية” التي تشكل جوهر هويته وتحدياته المعاصرة. هذه المفارقة تتجسد في عدة مستويات متداخلة تشكل معاً صورة معقدة لواقع أدبي فريد.
في علاقته مع الزمن، يقف الأدب العربي على مفترق طرق حرج – فهو يحمل إرثاً تاريخياً عظيماً يمتد إلى العصر الذهبي للأدب العربي، لكن هذا الإرث نفسه تحول إلى عبء ثقيل يكبل حركته نحو المستقبل. نجده غارقاً في حالة حنين دائم للماضي، عاجزاً عن مواكبة إيقاع العصر وتحدياته.
تمتد هذه الإشكالية إلى علاقة الأدب العربي بالهوية، حيث يستنزف طاقاته في السؤال المستمر “من نحن؟” على حساب “ماذا نريد؟”. فبدلاً من التعبير عن الذات بثقة، نجده منشغلاً بإثبات وجودها، مدفوعاً بهاجس المقارنة المستمرة مع الآداب العالمية الأخرى.
أما علاقته باللغة، فتتسم بإشكالية عميقة تتمثل في التعامل مع العربية كمقدس لا كأداة تواصل حية ومتطورة. هذا التقديس المفرط أدى إلى الاهتمام بالشكل على حساب المضمون، وخلق فجوة متزايدة بين لغة الكتابة الأدبية ولغة الحياة اليومية.
في علاقته مع السلطة، يميل الأدب العربي إلى المهادنة بدلاً من المواجهة، متخذاً من الترميز والتورية ملاذاً آمناً للتعبير، متردداً في طرح الأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بالحرية والوجود الإنساني.
وأخيراً، تبرز إشكالية علاقته مع القارئ، حيث يخاطب نخبة متعالية على حساب عامة الناس، مفترضاً وجود قارئ مثالي قد لا يوجد في الواقع، مما يعمق الفجوة بينه وبين الواقع المعيش.
هذه المفارقات تضع الأدب العربي في موقف شديد التعقيد – فهو يطمح إلى المعاصرة لكنه مقيد بالتراث، يتوق إلى العالمية لكنه منغلق على ذاته، يسعى للجرأة لكنه محاصر بالقيود، ويرغب في الوصول إلى الجميع لكنه لا يخاطب سوى القلة.
إن مستقبل الأدب العربي مرهون بقدرته على تجاوز هذه المفارقات عبر مسار متوازن يحترم الماضي دون أن يتقيد به، ويبحث عن هويته في المستقبل لا في التاريخ فقط. كما يحتاج إلى تحرير اللغة من قدسيتها المفرطة، ومواجهة الأسئلة الصعبة بشجاعة أكبر، وبناء جسور حقيقية مع القارئ العادي.
س: أعتقد بوجود العديد من الكتاب العرب الذين استطاعوا تقديم تجارب مهمة لا تخضع لتصنيفك الصارم! أميل هنا إلى ترشيح الروائي الليبي ابراهيم الكوني نموذجاً على سبيل المثال. هل يمكنك التفصيل قليلاً عن موقعه الثقافي المهم في الثقافة العربية؟
ج: يعد إبراهيم الكوني نموذجًا فريدًا في المشهد الأدبي العربي، لتميزه الثقافي والأدبي واللغوي. يجمع الكوني بين الثقافة العربية والطوارقية الصحراوية، مازجًا الواقعي بالأسطوري في أعماله، ومؤسسًا لأدب صحراوي يتميز بخصوصية عالمه. يتناول في أعماله قضايا الهوية برؤية كونية تتجاوز الثنائيات التقليدية كشرق وغرب أو قديم وحديث، مما يمنحه عمقًا فلسفيًا وإنسانيًا. علاوة على ذلك، يُظهر الكوني علاقة استثنائية باللغة العربية، حيث يُطوعها للتعبير عن عالم الصحراء، مُبدعًا معجمًا خاصًا يمزج بين الفصحى والتعابير الطوارقية، مع ابتكار أسلوب سردي متفرد.
على المستوى الفلسفي، تطرح أعماله أسئلة وجودية حول علاقة الإنسان بالطبيعة، مقدمة رؤية بيئية متقدمة ترتبط بالمكان، كما تتناول قضايا كونية من منظور محلي عميق. إبداعاته تشمل أعمالًا مثل رباعية “الخسوف”، و”نزيف الحجر”، و”التبر”، التي تُرجمت إلى لغات عدة وأسست تيارًا جديدًا في الرواية العربية. الكوني أيضًا تجاوز المشكلات التقليدية للأدب العربي، فلم يسقط في محاكاة الأدب الغربي، ولم يتعامل مع التراث بقدسية جامدة، بل عبر عن الذات دون الانشغال بإثباتها.
تأثيره يمتد ليشكل نموذجًا للكاتب العربي العالمي، فاتحًا آفاقًا جديدة للرواية العربية ومُلهمًا لجيل من الكُتّاب العرب. تُعد تجربته نموذجًا غنيًا يمكن البناء عليه في تطوير الأدب العربي المعاصر، ما رأيك في هذا الطرح؟
هل تتفق معي أن تجربة الكوني تمثل نموذجاً يمكن البناء عليه في تطوير الأدب العربي المعاصر؟
س: هو والعديد من الكتاب العرب الآخرين يشكلون نماذج مضيئة، ففي أعمالهم عمق إنساني وتنوع موضوعي. لنستعرضْ بعض هؤلاء الكتاب الذين يستحقون التقدير العالمي!
ج: نعم، هناك العديد من الكتاب العرب الذين قدموا نماذج أدبية متميزة تستحق الاحتفاء العالمي. فنجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب، قدم صورة شاملة للمجتمع المصري عبر الزمن، وبرع في المزج بين الواقعية والرمزية من خلال أعمال خالدة مثل “الثلاثية” و”أولاد حارتنا”. أما الطيب صالح فقد قدم في “موسم الهجرة إلى الشمال” نموذجاً فريداً في السرد العربي، معالجاً قضايا الهوية والعلاقة مع الآخر بعمق مؤثر عالمياً. وغسان كنفاني قدم أدباً ملتزماً دون إسفاف، عالج فيه القضية الفلسطينية برؤية إنسانية عميقة في أعمال مثل “رجال في الشمس” و”عائد إلى حيفا”. كما حوّل محمود درويش الشعر إلى خطاب إنساني عالمي، مازجاً بين الشخصي والعام بطريقة فريدة في قصائد خالدة مثل “جدارية” و”أثر الفراشة”. وقدم حنا مينه أدب البحر والمهمشين بعمق إنساني في معالجة قضايا المجتمع من خلال “الشراع والعاصفة” وغيرها من الأعمال المهمة. وعالج عبد الرحمن منيف في خماسية “مدن الملح” قضايا النفط والتحديث برؤية نقدية عميقة للتحولات الاجتماعية. وجدد أدونيس في الشعر العربي مع رؤية نقدية للثقافة العربية وتأثير عميق في الحداثة الشعرية. وقدمت غادة السمان كتابة نسوية جريئة في معالجة قضايا المرأة والمجتمع بأسلوب سردي متميز. ومزج واسيني الأعرج بين التاريخي والمعاصر في معالجة قضايا الهوية والانتماء بتجريب سردي متميز. ما يميز هؤلاء الكتاب هو قدرتهم على تجاوز المحلية إلى العالمية، والعمق الإنساني في معالجة القضايا، والتجديد في الأشكال الأدبية، والتأثير في المشهد الثقافي العربي والعالمي. هل ترى أن هناك كتاباً آخرين يستحقون أن يضافوا إلى هذه القائمة؟
س: سأتجاوز ذكر الأسماء لأنني أحب معرفة رأيك كيف تجاوز هؤلاء الأدباء العرب التابوهات الاجتماعية والسياسية والدينية في تناولهم للمواضيع الحساسة؟
ج: سأقدم تحليلاً لتجارب بعض الشعراء العرب المهمّين في تجاوز المحظورات:
محمود درويش تجاوز تابو العلاقة مع “الآخر” الإسرائيلي حيث قدم في قصيدته “عابرون في كلام عابر” رؤية إنسانية تتجاوز الكراهية، محولًا القضية الفلسطينية من صراع محلي إلى قضية إنسانية عالمية، كما تجاوز المقدس الديني حين ناقش في “جدارية” فكرة الموت والخلود بحرية فلسفية، مستعينًا بالنصوص الدينية في سياقات جديدة دون الوقوع في المحظور. نزار قباني تجاوز تابو السياسة، إذ انتقد الأنظمة العربية بجرأة في “هوامش على دفتر النكسة” واستخدم السخرية المريرة في “متى يعلنون وفاة العرب”، كما تجاوز تابو الجسد بكتابته عن المرأة وجسدها بأسلوب شعري راقٍ، محولًا “الحب” من موضوع محظور إلى قضية ثقافية. أدونيس تجاوز تابو التراث في “الثابت والمتحول”، حيث قدم قراءة نقدية جريئة للتراث وأعاد تفسير النصوص المقدسة من منظور حداثي، كما كسر بنية القصيدة التقليدية وأسس لحداثة شعرية عربية. أمل دنقل واجه تابو السلطة عبر قصيدته “كلمات سبارتكوس الأخيرة”، حيث استثمر التاريخ لنقد الواقع السياسي، وتجاوز المحظور الديني باستخدام القصص الديني في سياق سياسي معاصر كما في “البكاء بين يدي زرقاء اليمامة”، حيث مزج بين الأسطوري والسياسي. محمد الماغوط تجاوز تابو الطبقة الاجتماعية بكتاباته عن المهمشين بلغة مباشرة وصادمة، كاسرًا القالب اللغوي التقليدي للشعر، وتجاوز تابو النقد السياسي باستخدام السخرية السوداء لنقد السلطة وتقديم صورة قاسية للواقع العربي.
تجمع هؤلاء الشعراء استراتيجيات مشتركة تمثلت في توظيف الرمز والتناص، واستخدام المفارقة والسخرية، وتطوير لغة شعرية خاصة، والمزج بين الشخصي والعام، واستثمار التراث في سياقات جديدة. ونجحوا في تجاوز التابوهات بفضل عمق تجاربهم الشعرية، وقدرتهم على الابتكار الفني، وشجاعتهم في المواجهة، ووعيهم بأدوات التعبير.
س: برأيك ما هي الخصائص المميزة للأدب العربي والتي قد تساعده على الوصول للعالمية؟
ج: يتميز الأدب العربي بخصوصية فريدة تتجلى في قوته اللغوية الاستثنائية، حيث يمتلك نظاماً لغوياً ثرياً بالمجاز والاستعارات والتصوير، مع قدرة فائقة على التعبير عن دقائق المشاعر والأفكار، ومرونة ملحوظة في توليد المعاني من الجذور اللغوية. ويتعزز هذا التميز بتنوع ثقافي غني، يجمع بين تراكم الخبرات الحضارية المتنوعة من عربية وإسلامية ومحلية، مع قدرة لافتة على استيعاب وتمثل التأثيرات الخارجية دون المساس بالهوية الأصيلة.
ويتعمق هذا التميز من خلال عمق التجربة الإنسانية التي يحملها، متمثلة في تراث غني من التأمل الفلسفي والروحي، وتجارب تاريخية عميقة في مواجهة التحديات الوجودية، مع قدرة خاصة على المزج بين الواقعي والرمزي. وتتجلى مرونته التعبيرية في تعدد الأشكال الأدبية، من القصيدة العمودية إلى قصيدة النثر، مع إمكانية المزج بين التقليدي والحداثي، وقدرة متجددة على تطوير أشكال أدبية جديدة.
كما يمتلك الأدب العربي طاقة تجديدية كامنة تظهر في وجود تيارات تجديدية قوية عبر التاريخ، وقدرة متميزة على إعادة تفسير التراث برؤى معاصرة. غير أن تحقيق هذه الإمكانيات يتطلب توازناً أفضل بين احترام التراث والانفتاح على الحداثة، مع مرونة أكبر في التعامل مع اللغة، وشجاعة في طرح القضايا المعاصرة، وانفتاحاً حقيقياً على القارئ العادي.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.