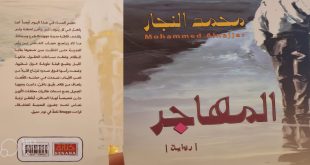طلال مرتضى |
الكاتب الذي صار خارج نص الحكاية، أنا.
للتو وقعت أسيراً في شرك الحبكة. كان عليَّ التوقف على الأقل بين جملتين اعتراضيتين لاستكشاف الطريق، أو التلظي وراء قوسً منحنٍ بعد نقطتين من مفاتيح القول.
بالطبع لن يتوقف النقاد عن دسَّ تُرهاتهم طي مفاز النص؛ وفي أحسن الحالات سأتلمس شماتتهم، بعدما تتصدر الصحف في اليوم التالي، عناوينهم السليطة بالمجاز المبطن.. وما نقدناهم ولكن كانوا نصوصهم يكسرون.
أمس بعد أن استحممت ببقايا ضوء مُجعد ـ تهدل عن غير نية، من عمود إنارة بائس، دوح سهل الصقيع الممتد حتى ضفاف “الدانوب”ـ هززت شجرة الذكريات كي أتعطر بما تيسر لي مما بقي عالقاً على مشجب البلاد التي لفظتني مثل ولد عاق.
عُدت إلى الوراء بفعالية السرد خلفاً “فلاش باك”لبرهة, كان مخاض المنولوغ عسيراً في كل المطالع، فالجعبة خاوية الا من جملة الخسارات، التي ما فتئت تنزاح واحدة حتى تتجلى أخرى، وكأن يد القدر شاءت أن ترمي بكل خيباتها على عاتق هامشي المتخم بالانكسارات.
الليل المكين تلحف بالصمت، بدا وكأنه عابر حبر لا يدري في أي السطور يهجع، مثله مثل أي غريب لا ظل له.
كان لا بد من كسر رِتم نسق القصة، ليل المغترب يحتاج أن تُولم له كل ممكناتك، لتبدد صقيعه.
جلَّ ما تحتاجه لحظات السكون هذه، أن استعير من رواية “مقصلة الحالم” عواء الذئب “سرحان”، وحده “سرحان” قادر على تمثيل الدور بعناية فائقة، تجعل من جمهور العزلة يصفق بشكل محموم حد احمرار الأكف.
عواء الذئب في فراغ صحراء الروح، أشبه بمعزوفة “تشيلو” تخرجك عن طورك المألوف، تودي بك نحو نواصي الورق، كأقل خسارة تُمني بها دفتر الخيبات المتراكمة.
ادرك بأن الليل يشبهني في اليُتم، في الهباء، في السكون؛ الفرق بسيط بيننا، وقد نتعادل واحدة بواحدة، أو قد أضاهيه، حين امتلكتُ أربعة جدران وسقف كئيب الضوء، بينما بقي هو متفلتاً في شوارع عزلته، ينظر نحوي من خلف النافذة العجفاء يصفر شزراً.
لا شك أني بت أشعر بالتواد بيننا، كأخ لم تلده أمي، ورضيت به أنيساً على الرغم من طبعِ الغدر الذي يحتريه،لحظة انشغالي عنه، ليدسّ سمه في عظامي مثل مخدر منتهي الصلاحية، كان يعرف أن في البرد مقتلي، فيدهمني.
لا مناص.. بأن النص قارب الخواتيم، وبات يتوسل القفلة، كنزقٍ أخير عند خط النهاية، يرفل أنفاسه على مضض الحبر, ما كان عليَّ فتح صندوق الوجع على ضوء شمعة، تبتبت لحن انطفاءها بالبكاء. لستُ أدري لفرقة العسلِ أم من حرقة الفتل.
من باب السليقة أعرف أن النهايات المفتوحة تجعل من القارئ المفترض شريكاً، لكنه التوجس الذي يسكنني وأنا ادخل تلافيف دماغ القارئ المتعطنة، بأن تأويلاته اللا محسبوبة سوف تشده نحو الشبهة التي اتحاشى السقوط في غياهبها، لذلك تعمدت أن أسدَ نهم قفلتي بنهاية مشرفة، أخالها كلاسيكية المعطى، أو أقرب إلى نهاية فيلم هندي، يدمغ بكلمة “END” عند زواج البطل من البطلة أو موتهما.
سرت رجفة مفاجئة في أوردتي، تقارب مطالع رعشة النشوة، مع فارق المذاق، بعدما صحا هاتفي المسجى على أريكة غيبوبتي، معلناً أمتلاء المذخر..
بالطبع جلّ ما أكره هو قطع صلة الأرحام، حين قمت وبدون تردد بفصلِ حبله السري عن القابس. الفرصة مواتية باتت لإطفاء الشمعة الكئيبة والاستلقاء على الأريكة بات مطلباً، بعدما قررت القيام بجولة تفقدية للرسائل الفائتة..
مما لا شك فيه أن إغلاق الهاتف لعدة ساعات في ليلة الميلاد أمراً صبعاً ولا يقاوم.. كانت القصة أشبه بضرب تحدي، ولِما لا وأنا المقطوع حتى مني!..
الشجرة التي خرجتُ من لدنها فنن ثم غصن، ماتت وقوفاً وتناهشتها فؤوس الحطابين قبل أن يشتد عودي. فكان قرار العودة إلى الورقة والقلم، مقابل إخماد هذا الدخيل الذي لا ينفك عن مشاغلتي بنقله لأخبار الحرب وويلاتها في تلك البقعة التي وسمتها على روحي ببلدي.
ما أن تعمشق على هواء الشابكة _النت_ مثل طفل أمسك بتلابيب أمه في غمرة الازدحام، حتى انفجر زاعقاً بعشرات الرسائل التي تجمهرت مرة واحدة عند كيبورد الكلام..
كان هذا بعد فسحة صمتي بقليل، قبل استيقاظ أصابعي من شهوة الكتابة، تماماً عند أطراف سهل اللغة الممتنع، وقت تجمهرت عقارب الساعة فوق رأس منتصف القصيدة.
الشاعر الحالم جل ما يشغله، اجتراع قصيدة لم يخل وزنها شاعر قبله.. لا ضير لو نثرها نصاً متماهياً في غموضه حد الدهشة، فوق يباب ديوان ضَل دوال معانيه في قلب الشاعر..
القصيدة ذاتها لم تعمر طويلاً، حين عاد بها البيت، ضل طوال الطريق متأبطاً الصحيفة التي نشترها، مثل عشيقة، لا ينفك عن شم حبرها المائز. استفاق متوهلاً على حلم بغيض، حينما وجد زوجته تُمسح بها زجاج النوافذ، تمتم بحرقة: والكاظمين الغيظ.
مُنذ تلك الواقعة أيقن بأن لا قيامة للشعر، وأن انتظار مهدي القصيدة بدعة حقة يراد بها الحضور، اجترعها شيطان القريحة كي بُجبر بها كسر رِتم المقال..
لم أسكت، بل دونت أحتجاجي _ كـ أضعف الأوزان_ على شريطِ المهجة العاجل: “والحبر إن الشعر لفي قهر.”
ما أدهى هذا الليل، رغم بؤسه، رغم البرد الهاجع في كل تفاصيله، لا ينفك عن نكزِ خاصرة الذاكرة، يدس أصابعه في أنف الوجع ليعطس من نخاعه، حينها يلملم ما تبقى من خيوطه وينهج متخففاً نحو سكة قطار الصبح، بانتظارِ موكب الشمس القادمة من شرق كوكب الحكاية.
الكاتب الذي ما فتئ يتلمس زجاج غرفته في المغترب البعيد، بحثاً في المجاز عن كسرة قصيدة، قبل عشرون عام مسحت زوجته بها آخر حلم له، أنا..
كابد كل أصناف الكتابة، أولم لها كل ممكنات القول، مارس وشيطانة الشعر دعاية الفكر، قاسمها سريرة الغواية، لم يتوانى للحظة بأن يدفق في حوض رغبتها حبر روحه, بصراحة.. أنا.
لا تنظروا إليَّ بشرر، لا أحب الأحكام المتسرِّعة؛ بالتأكيد لكل قصيدة مبرر.
مرَّ وقت طويل، تجاوز عمره ثلاث وعشرين قصيدة ونيف، كعلامة فارغة، فاصلة، ما بين تاريخ الهجرة والميلاد، يوم تعرضت للاغتصاب من قِبل (المصير المُسير) كنت حينها في غمرة التحضير لكتابة رواية. “يتبع”.
كاتب سوري ـ النمسا | خاص موقع قلم رصاص
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.