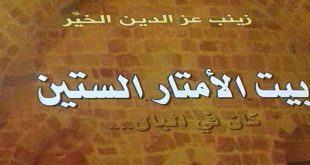“ليس مجرد حفل توقيع وينفضُّ الجمع”
“لم تساعدْها أجهزة الصوت فأنقذها الشعر”
“النجاةُ حدثٌ مملٌّ للغاية” يستفزني العنوان، كأنه يخبرك بطريقة عكسية أن القراءة ستكون مثيرة للغاية إنها مجموعة شعرية جديدة، ومع كل جديد يتكرر السؤال الفني المبهر الذي استهل به عنترة العبسي معلقته: “هل غادر الشعراء من مُتَردَّمِ” ؟
هل ترك لنا الشعراء شيئاً لم يتناولوه في شعرهم حتى يتجرأ مغامر (ة) جديد لخوض المضمار؟
وهل مَن يأبه لكتاب شعري جديد، في زحمة الإصدارات التي يفتقد معظمها الحد الأدنى من السوية الفنية وحتى اللغوية – النحوية؟
لقد تجرأت سارة حبيب وفعلتها، وحسناً فعلت، امتلكت جرأة المحاولة، ومن الـ(مُتَردّم) إلى (متردمات) كثيرة، حفلت مجموعتها الشعرية بإدهاشات كثيرة، في زمان يبدو أن ما يدهش فيه هو أن يتمكن نص ما من صنع الدهشة! العنوان المليء بالحمولة (المعنوية) يفرض نفسه؛ “النجاة حدث ممل للغاية”!

إذا هو يفترض وجود ناجين، ووجود آخرين غير ناجين، والفارق أن غير الناجين قاموا بمغامرتهم، فيما الناجون يجترّون أوقاتهم بملل شديد، وربما كانت تسليتهم الوحيدة أنهم يتداولون أخبار غير الناجين؛ أولئك الذين كسروا الملل، وامتلكوا جرأة خوض التجربة، ولنلاحظ هنا أن هذا العنوان أطلق الحالة فلم يحدد النجاة من ماذا؟، ولم يحدد مصير غير الناجين؛ ربما كان الاقتصاد والتكثيف من صفات العناوين، لكن هذا العنوان قفز إلى نتيجة مبهرة بدت كأنها حكمة أو مقولة، تحمل فيما تحمل الإشارة إلى (الفاعلية والسلبية) في الحياة، وبالتالي تشخّص قيمةَ الأفراد من خلال تلك الفاعلية، والناجون في الغالب هم السلبيون الذين ارتضوا أن يكونوا متفرجين!
لوحة الغلاف البارعة للفنان وضاح السيد. قد يبدو الخوض في كتابة نصوص شعرية من طراز قصيدة النثر محفوفاً بالمخاطر، وكثيرون التبس عليهم مفهوم قصيدة النثر، فبعضُهم اعتبرها نثراً ليس إلا، وبعضُهم اعتبرها من الحداثة الشعرية، وبين هذه وتلك تأتي المخاطرة، فشاعر – قصيدة النثر- عليه أن ينشئ في نصوصه شاعرية خالصة، رغم أن نصه مجردٌ من وسائل الدعم، كالوزن والقافية والإيقاع، ومن هنا تنبع صعوبة الكتابة في هذا الصنف الأدبي.
على النص إذاً أن يقنع القارئ أنه يحمل في طياته روح الشعر، وروح الشعر هذه هي بالذات ما يبحث عنه الشعراء منذ القصيدة الأولى، رغم الاختلاف والتباين في المدارس الشعرية من الكلاسيكية حتى ما بعد الحداثة بمفهومها الفني، والفلسفي.
………
في كتابها انسابت قصائد “سارة حبيب” جامعةً للكثير من فنون الكتابة الشعرية؛ نصوص بدت فطرية، غير متكلفة، من نوع السهل الممتنع. شكلانياً اتخذت شكل قصيدة الومضة، الفائقة التكثيف، مع بضع مقاطع أطول قليلاً لمبررات فنية يأتي إقناعها في سياقها، وفي الحديث عن التكثيف سوف يلاحظ القارئ أن مقطعاً من جملةٍ أو جملتين أو ثلاث حفل بتضمينات ومعان غزيرة وأعماقٍ بعيدة الغور، وأنها أي تلك النصوص لا تحتمل التأويل فقط لكنها تبقى مفتوحة على معانٍ معانٍ تصل حد الحكمة، وحدَّ الإطلاق، وحدَّ التضليل في الوقت ذاته.
إنها تزوغ عن المعنى وتثبته، وتنبش ضده. نلاحظ ذلك من المقاطع الأولى في المجموعة:
واحد حياة إلى الطاولة عشرة
يصرخ النادل ويشير إليّ
وما من رب يأخذ الطلبات.
مفردات قد يبدو تجانبها منافياً للمنطق، لكنه الشعر الذي يقرب المعادن المتنافرة؛
حياة، طاولة، نادل، زبون، رب، طلبات.
ثلاث جمل، تختزل حكاية، مأساة، ملهاة؛ الوقت المبعثر في جلسات المقاهي، لوجهٍ فقد ماءه، فأشفق عليه النادل (الذي اعتاد مشهديتَه)، وطلب له الحياة، ولكن ..
أهي القدرية أم المشيئة التي تبقي هؤلاء الأموات أحياءً، وهل الموت هو بالمعنى الحرفي أم بالمعنى العبثي حيث لا قيمة أو لا وجود معنوياً لأحياء أموات ولا أمل منهم ولا قدر يساعدهم؟
……
جملتان خبريتان غير مكتملتي العناصر حيث الخبر فيهما (أو الفعل) مضمر، ويحيل إلى تزامن ما أو رتابة ما، مربوطتان بـ (واو) تخلقان أيضاً فيضاً من المعاني والدلالات، نقرأ:
العيش البطيء
والحب السريع
تلاقح بين متضادين، أحدهما (العيش) ممل بليد لا تكتنفه المفاجآت بسبب بطئه، والآخر (الحب) لا طعم له ولا لون ولا دهشة (ممل أيضاً) لكن بسبب سرعته، الله!
…..
أيضاً وأيضاً نقرأ:
“الطريق إليك
حين أخوضه في رمال الفضيلة المتحركة”.
هي براعة الاستعارة (رمال الفضيلة المتحركة) فالفضيلة إذا نسبية ومتحركة القيمة، ونسبيتها زمانية ومكانية وفكرية وأخلاقية، وبالتالي فإن اختيار نسبيتها خاضع لقرار صاحب العلاقة، وربما لتفاوت قيم المجتمعات.
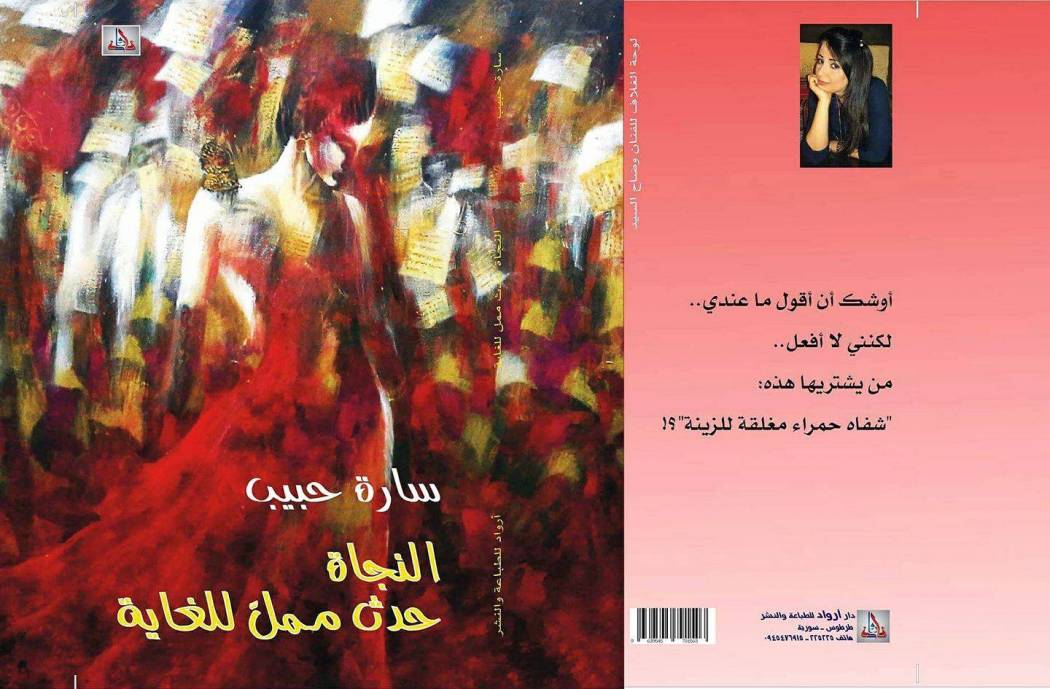
ويحافظ التدفق الشعري على عزيمته فنقرأ:
الشبح الذكوري الذي يقول لامرأة ثوري
يهرب متلاشياً قبل أن تصل ذات المرأة لحرف الباء في كلمة أحبك، نسيج ذكي، وحل فني شعري لغوي مبتكر لحالة أنانية الذكر في علاقته مع الأنثى، ذلك الذكر الذي تمَظْهر مثقفاً ومتفهماً للأنوثة، وداعية لحريتها، لكنه في لحظة بلوغه لذته، ينتهي أنانياً غير عابئ بشريكته، ومتنصِّل من كل ما زعم أنه ينادي به.
ويستمر التكثيف الأنيق:
*خانة صغيرة في بطاقة لاتعني بالضرورة أنك حد ما!
*كلما رفعتَ يدَكَ من بعيد تحسستُ مائي.
*أنا لا أرتعشُ قبالتك لأنني أحبك
بل أحبُّك لأنني قبالتك أرتعش.
*بقفزةٍ عمرية واحدة يثب الوطن
من طفل يتناول الآيس كريم لعجوزٍ بلا أسنان.
* أودُّ –كحلٍّ أخير- أن أحبلَ بك لا شيء أصلح من هذا لاحتباسك داخلي.
* لا تُسقطُ الحرب الأقنعة بقدر ما تركبها.
* كما يستبدل الحب بالحب تزاح الصداقات بالحب الطفيف والحب الطفيف بالحب الشاهق والحب الشاهق
بالنسيان.
* بقدر ما أتكئ عليك بقدر ما يختل توازني..
* مغمض العينين تجتاز الامتحان
الذي يرسب فيه جميع الرجال
بالتشابه.
* كانت فكرة ذكية أن تُخلق للرجال أكتافٌ فلولاها ما كنا وجدنا عندهم
مساحةً للاتكاء.

أوردت هذه الأمثلة كنماذج، مع التأكيد على أن المقاطع التي لم أوردْها لاتقل فنيةً وأهمية عنها، لكن بالطبع لا يمكن إيرادها جميعاً.
تميزت مجموعة “سارة” إذاً بالتكثيف الشديد، وبحنكة الابتعاد عن التكلف والصنعة، فجاءت العبارات سلسة اقتصادية اللغة، ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن البناء اللغوي في المجموعة جاء متيناً معبراً بانتقاءِ مفردات تصيب دلالتها مباشرة في غنىً وتدفق لغوي لافت.
اعتمدت النصوص أيضاً على ربط الدلالات، وحيثما احتاجت أعطت الجمادات حياة، وقطعت بجمود بعض الأحياء، فكانت فكرة الحركة والجمود مرتبطة بالفاعلية والرمز أكثر من كونها مرتبطة بحركة الكائن (أو الشيء) من عدمها.
إنها نصوص استطاعت أن تعمل على الأطراف المتعاكسة أو المتوازية، وتمزج فنياً بين الأجناس غير المتجانسة.
وفي هذا السياق نلاحظ في كثير من المواضع تمرداً نصياً معنوياً وفنياً على الموروث أو المسلَّم به، تبدّى هذا التمرد بتفكيك المبني (المتشكل) أو بعثرته، وإعادة بناء المبعثر وتشكيله وفق الرؤية الجديدة التي تبناها النص، فكأنها عن عمد تلعب في تلك المنطقة الحرجة (بين بين)، جاء في السياق:
“الخمسون كتابا التي اشتريتها
لا تعني بالضرورة حبي للروايات
يحتمل أنها تعني فراغا عاطفيا يستنجد الحشو أو محاولة للملمة رواية ذاتية
من بعثرات الحبكات”.
………
اتخذت النصوص من العادي اليومي مادة لها، وتنقلت بين المقهى والشارع والبيت وظروف الحياة، وببساطة تمكنت من
فلسفة العادي، واستنباط الأعماق، وتجريد الدلالات، والانتقال من الخاص إلى العام، وهي لم تتطرق مباشرة إلى ظروف الحرب، لكن إشاراتها كانت حاضرة بقوة، وكان جزءاً كبيراً من المشاعر والانفعالات والسلوكيات (الظاهرية والعميقة)، وحتى الإحساس بالعبثية، واقتناص اللحظة العابرة، والرضى بالقليل الممكن، من تأثيرات الحرب الكارثية بشكل عام.
كل ذلك بدا مباشرة (أو بشكل غير مباشر) في نصوص المجموعة، فكأن الحرب هي الخلفية المبهمة القاتمة الحزينة لفضاءات القصائد، أو الخيط المستتر الذي يربطها، وكأن هذه النصوص هي (بالتعميم) مرآة صادقة لحياة الناس في ظروف الحرب (مطلق حرب)، بما في ذلك الحرب على سورية
ومع ذلك فقد نجحت النصوص في تجنب الخوض بالإيديولوجيات أو الانحياز لإحداها، لقد انحازت فقط
للإنسان، وخصَّت الإنسان (الأنثى) بنصيب كبير من التحليل والكشف والإضاءة، فامتلكت جرأة الخوض في المحرم، وجرأة التعبير عن كينونات الأنثى بأحوالها المختلفة، وبخصائصها في رؤية الأشياء والأحداث على طريقتها، وفي علاقتها الأمومية بالذكر – على كل الأحوال- خاضت في حاجتها إليه، وفي استغنائها عنه سواء بالحلم أو بالواقعية. برز في المجموعة أيضاً عنصر فني هام، هو التهكم بمفهومه الفلسفي (السقراطي)، ذلك التهكم المرير، الذي ينشئ من المفارقة أو من السخرية اللاذعة معنى فارقاً؛ أتذكَّر:
“جثث من مختلف الألوان بلدٌ يمدّ يده بتثاقل..
يمسك ال (ريموت كونترول) يطفئ التلفاز
وينام ..”
وبعد:
في هذه العجالة وهذا التدفق الإيحائي الذي تحيلنا له نصوص مجموعة (النجاة حدث ممل للغاية)، أقول: إن المجموعة تحتاج لقراءات وقراءات فنية ونقدية، ومن حق الفن الحقيقي على من يمتلكون ملَكةَ النقد والإبداع أن يقدموا قراءات جدية تغني وتفيد في تشريح العمل.
لقد قدمت الشاعرة “سارة حبيب” صوتاً شعرياً ناضجاً يمتلك أدواته، ويمتلك أيضاً رؤيته للكون والإنسان والغيب والعواطف الإنسانية الجياشة، صوت مجدد ابتعد عن النمطيات والتقليد، صوت يدرك فلسفته ويستطيع أن يقول كلمته، ويصيب هدفه، وهو إلى جانب ذلك كله (وهو الأهم) صوت يمتلك تلك الموهبة الشعرية الفنية المضيئة.
كاتب سوري | خاص مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.