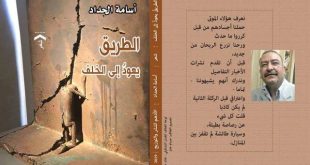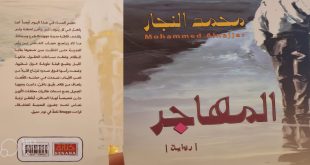استيقظت باريس صباح أحد الأيام الباردة، عام 2015، على الصورة القاسية للعالم، حيث أن مرآة الكراهية أظهرت لكل واحد من سكانها، الوجه المدفون في داخله، الصورة الصافية للوحش الذي لم تمسه الحضارة قط.
وفي الحقيقة، إن أول إشارة للوقائع، جاءت عبر اتصال لم يكن يحمل أيّ قدر من الغرابة ولا يعبر عن أية إيماءة بخصوص المستقبل المظلم، وكان الضابط في مركز الطوارئ يستمع ويدون المعلومات التي هي عبارة عن شكوى سيدة في الأربعين اسمها صوفي ضد زوجها الاستاذ في معهد اللغات، والذي قالت عندما سألها الشرطي عن اسمه: ستيفان، الخنزير ستيفان. قالت أيضا إنها لم تعد تحبه، هكذا فجأة، شعرت بذلك، وكأن شيئا ما انطفأ في داخلها وأصبح مثل الرماد وقد تطاير في الفراغ. وكانت ــ كما أضافت فيما بعد ــ قد اعترفت له عندما كانا في سرير الحب بشعورها هذا، وأنه صفعها قبل أن يسألها عن الأسباب: ستيفان الذي كان مثل الخروف، تحول الى كركدن هائج. قالت صوفي وكان صوتها يتهدج: أنت قحبة، ولم يكن لي الدليل على تتويج هذا الشعور الذي رافقتي منذ زمن طويل، حسنا، إنك تعترفين الآن، ويبدو أنك وجدت من يضاجعك أفضل مني، ثور آخر يصلح لتهدئة النار التي تتأجج في فرجك.
نقلت السيدة صوفي بالحرف الواحد كلام زوجها واعترفت أنها صفعته أيضا، بل إنها غرزت أظافرها في وجهه كما يفعلها نمر، لكنها استعادت أيضا في تلك اللحظات المتوترة بعض الإشارات التي تؤكد خياناته، ثم تشكل لديها يقين لا يمكن تفنيده،أنه أغوى الكثير من طالباته: يا للقذارة!، هكذا وصفت في النهاية الأمر وكانت قد انخرطت بموجة بكاء شديد، طلب منها الضابط ان تهدأ قليلا لكي يستكمل تدوين المعلومات، لكنها كانت تلوم نفسها بسبب الغباء الذي جعلها لا تعرف حقيقة هذا السافل الذي عاش معها عشرين عاما، ثم دارت معركة شرسة بينهما كما وصفتها، استخدمت خلالها كل الأدوات الممكنة حتى سالت الدماء وتحولت الشقة خلال نصف ساعة الى مكان كما لو أن قنبلة قد انفجرت فيه للتو، معركة لم تبقِ شيئا في مكانه المعتاد، وأكدت أنها الآن خارج المنزل، وهو كذلك، لا تعرف أي جحيم ابتلعه، بل تمنت أن يظهر تمساح من النهر ويطحنه بين أسنانه.
ثم انهمرت المكالمات من كل أحياء باريس، نساء ورجال، شبّان وعجائز، أزواج وعشاق لم يدخلوا بعد نطاق الزوجية، مواطنون وأجانب مقيمون وحتى من السيّاح. ثم أعلنت وزارة الداخلية عند الثانية صباحا الاستنفار، فقد سجلت جرائم قتل منها واحدة قام بها شاب ودفع خطيبته في نهر السين، وهناك جرحى كثيرون وحرائق بسبب المشادات التي حدثت في الشوارع، ولم ينته الأمر عند ذلك، كان حريق الكراهية يتسع ويشمل تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وفي الواقع كانت ليلة لم تمر بها باريس منذ أيام الثورة الفرنسية، انقلب كل شيء ولم يعد من الممكن الحديث عن حالة طبيعية او حتى أمل بالعودة للساعات القليلة التي سبقت الكارثة، ولقد تحدث الناس عن كون هذه الوقائع هي مفصل مهم في تاريخ باريس، خاصة وأن الاجهزة الامنية قد فقدت في النهاية القدرة على احتواء الموقف، واستعانت الحكومة حتى بقوات الجيش الفرنسي، رغم ذلك، كان عشرات الآلاف من البشرغير قادرين على تأمين الاتصال بمراكز الشرطة للابلاغ عن الاعتداءات التي تعرضوا لها، وكان أول تقرير مرعب وصل الى رئاسة الجمهورية، يتعلق بعدد المنتحرين، حيث فقد الكثيرون لسبب غير معروف ــ كما يقول التقرير الأولي ــ القدرة على العيش تحت وطأة الشعور الكامل بالكراهية، وانعدام العاطفة في مدينة قذرة، كما وصفها أحد خبراء الشرطة الجنائية، وأضاف: أن باريس في هذه الساعات تشبه تلك المدن المتخيلة في أفلام الدستوبيا. حسنا، لقد طلع النهار أخيرا، وانكشف لسكان باريس شيء سبّب الذعر، خاصة لهؤلاء الذين لم تصبهم اللعنة بعد، فالخراب شمل كل شيء، تعطلت المؤسسات والمدارس والجامعات في ذلك اليوم، حتى الصحف امتلأت بمقالات وأخبار، منها ماهو غير صحيح، لكنه يعبر عن عدم النزاهة والمهنية، استخدمت لغة في القنوات الفضائية ولأول مرة تتضمن عبارات من قاموس منحط، شتائم وبذاءات يشيب لها الرأس، لم يسمع بها الكثيرون، لأنها كانت مخفية في الكتب القديمة، حتى المثقفون من كتاب وفنانين وأساتذة من المفروض أنهم محترمون، ظهروا في صباح ذلك اليوم وكأنهم بالونات مليئة بالخراء، انفجرت بشكل مفاجئ، ثم ظهرت لاول مرة كلمات أجنبية من كل اللغات، وبالتحديد هي شتائم مقززة، ويبدو أن الناس احتاجتها للتعبير عن العدوانية التي تغلي في صدورهم، والتي لم تستطع الكلمات الفرنسية تهدئتها، وكانت المستشفيات قد امتلأت بالجرحى، ثم شمَّ الناس رائحة غريبة، سموها من باب المجاز رائحة الكراهية وقد انتشرت في سماء المدينة مثل أعمدة دخان، تجمعت واختلطت، فصارت غيمة كبيرة تخنق باريس، الأحياء والاطراف والمناطق الزراعية التي تحيط بها كذلك.
لكن شاعرا اسمه الكسندير جاردين، ويلقبونه القديس فالانتاين رجل في الستين يقدم برنامجا إذاعيا معروفا، وقد تعود كل سكان باريس على الاستماع يوميا الى اختياراته الموسيقية والشعرية والنثرية لرامبو وبودلير وايلوار وبريتون وفولتير وهوجو وأديث بياف وجاك بريل، لكن الرجل أعلن في ذلك الصباح الرمادي، وعند بداية بث البرنامج، انه يعرف السبب الذي قاد الى الكارثة، وكان الكسندر قد تعود منذ زمن طويل على المرور على جسر البوزاغ كل يوم، ينفث دخان سيجارته، ويرتدي معطفه في مثل هذه الأيام الباردة، حيث يكون في منتصف الجسر عند منتصف الساعة الخامسة صباحا، ليصل في الوقت المناسب، فيبدأ في بث أول فقرات برنامجه عند السادسة وخمس عشرة دقيقة بصوته الجميل، قال: إن على الحكومة طلب المساعدة العاجلة من الاتحاد الاوربي، عليهم أن يرسلوا فرق غطس إضافية مع معداتهم، عليهم استخراج كل أقفال الحب التي قامت بلدية باريس في الليلة السابقة، وبحركة حمقاء بازالتها، ورميها في النهر.
لكن بيان الحكومة عند الساعة التاسعة، أكد أن هذا الاجراء غير ممكن في ظل الظروف الحالية، عمل سوف يأخذ وقتا، بينما المدينة تتحول الى حقل واسع من المجانين، أو ساحة للموت يسيل في شوارعها الدم، ثم عاد الكسندر عند الساعة العاشرة باقتراح أفضل كما وصفه، قال: إنه من الممكن جدا أن يقوم جميع السكان الذين يشعرون انهم غير طبيعيين، هؤلاء الذين وقعت لهم أشياء غريبة فظهروا كأنهم لايشبهون أنفسهم، الرجال والنساء الذين اشتعلت في قلوبهم نار، وامتلأت أنوفهم برائحة من دخان الكراهية، هؤلاء الذين أمام المرايا شاهدوا صورتهم البدائية، بأن يشتري كل منهم قفلا ويعلقه على جسر البوزاغ. والحقيقة كانت هذه الفكرة عظيمة، ومع تقدم الوقت، كانت الأمور تسير نحو التحسن،ثم لم ينته نهار الرابع عشر من شباط حتى امتلأ الجسر بالاقفال مرة أخرى، بل أن عددها تضاعف، ثم عادت باريس عند الساعة السابعة مساء الى حالتها الطبيعية، فتحت المقاهي والبارات، واشتعلت الأضواء في المنازل، وسمعت الموسيقى في كل مكان، ولم يتلق مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية أي إشارة غير طبيعية خلال الليل.
مجلة قلم رصاص الثقافية
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.