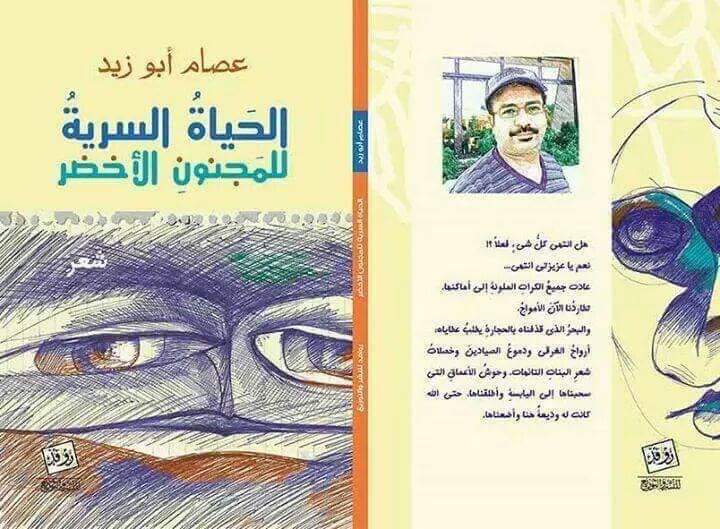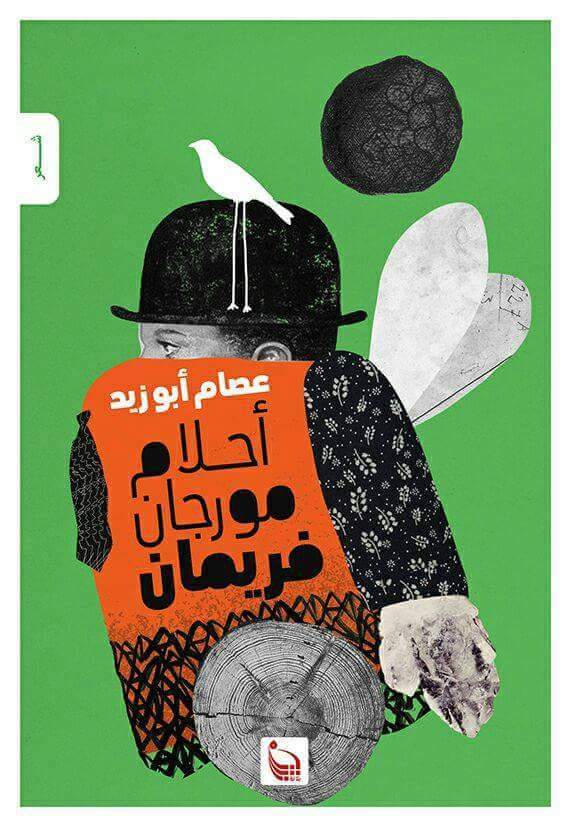ـ استهلال:
يُفترض بمرتكب الشِعر، المنثور منه خاصّة، أن يكون معجمه الشعري زاخراً بالمفردات والصور والرؤى والتشابيه والاستعارات والكنايات، أن يكون عميقاً ومكثّفاً وبليغاً في إيجازه، لأنَّ الشاعر ليس قاصّاً أو روائيّاً على سبيل المثال لتكونَ لغته سردية بحتة.
الشاعر الحقيقي هو الأكثر قدرة على الحذف والإضافة والاصطفاء والتحليق والتجويد، وهو المقروء منذ عقود، المُكَرَّس، والمتعارف عليه إعلامياً ومنبرياً. لكن.. ومع إقرارانا، الذي لا لبس فيه، بالريادة، والفرادة، لهذا النوع من الشعراء، إلا أن الأمرَ ليبدو بغير مستساغٍ على المدى البعيد، فالقراءة الموغلة في الترف والتقشيب تكون في بعض الأحيان مدعاة للملل والنمطية، فقط لأنه شعرٌ مترفٌ، فقط لأنه شعرٌ قشيبٌ، ولأننا قد نصرخ ذات قراءة: ها قد اكتفينا.. وارتوينا، فماذا بعد!؟
نحن إذن إزاء تحدٍ خطير، ملغوم، وبالغ الحساسية، تحدٍ يكمن في البحث عن الجِدة والتفرّد، المجدول بشيءٍ من التمرّد الجريء، المدهش، والمصحوب بالمغامرة، فالانقلاب على الرتابة والكليشيهات. وعليه.. فمن النادر جدّاً أن نتعثّر وسط هذا الكم الكبير من الشعراء ـ شعراء الغرام والرثاء والطلاسم والأحاجي والمناسبات والأعياد الوطنية ـ بشاعر ديدنه المغامرة، أنا مثلاً تروق لي قراءة الشاعر المغامر، المتمرّد على القوالب، وغير المُرضي للنقّاد، خاصّة من لا يتوانون عن نعتِ شعرِ كل من انقلب على الخليل بن أحمد الفراهيدي وأوزانه بالزندقة والهرطقة، الشاعر الذي يروق لي شاعرٌ يكتب ويمضي، يكتب لأنه بحاجة لان يفرغ شحنة ما، يدوّن حالة يعيشها، ولا يكترث بالتالي لما سيخلص له القارئ من انطباع، أو حكم، المصري عصام أبو زيد من هؤلاء الشعراء المغامرين، تلمّستُ ذلك من خلال حرصي الدؤوب على قراءة جديده، وهو في كل نصٍّ أو ديوان جديد له يحلّق عالياً في فيافي الشعر وأمداءه بكلمات عاديّة تارة، ومغرقة في المباشرة تارة أخرى، لا يتكبّد عناء الحرص على الشعرية في تدبيج صورة، ولا يلهث كذلك وراء مفردة مشذّبة، الشعرية عنده تكمن في القطعة ككل، في فكرتها أيضاً، وفي حكايتها كذلك، يعي تماماً ما تنطوي عليه الكلمة من شحنات، ووظائف، فلا تخونه إذ يغامر بزجّها في متنه نشداناً لاكتشاف ما مثلاً، يعي أيضاً كيف تُستعمل تلك الكلمة في موضعها المناسب، وهو الأمر الذي تلمّسناه بعد قيامنا بحذف كلمة، أو استبدالها بأخرى، على أكثر من مقطع، وفي أكثر من قصيدة، إنه باختصار يعوّل على الروح فيها، والمُضمَر، الشعرية في مختبره الشعري لا تكون في الكلمات المشذّبة، أو الرهيفة، ذات الجرس الموسيقي، الخافت والمنثال فقط، بل بما تنطوي عليه تلك الكلمات من حالات واستيهامات وتثوير وحمولة شعرية وشعورية جنباً إلى جنب، وهو يعوّل على الحكاية كعمود فقري لمقطوعته الشعرية، يعوّل أيضاً وبالمقدار ذاته في قفلاته على الدهشة أو الصدمة، وسنأتي على كل ذلك، تحليلاً، وتركيباً، وبشيء من التفصيل.
سنحاول في هذه المقاربة أن نعرج على المسار الشِعريّ للشاعر من خلال التطرّق لأربع من دواوينه الشعرية، وهي: كيف تصنع كتاباً يحقق أعلى مبيعات؟، أكلت ثلاث سمكات وغلبني النوم، الحياة السرية للمجنون الأخضر، وأحلام مورجان فريمان، وسنبدأ أوّلاً بديوانه كيف تصنع كتاباً يحقق أعلى مبيعات؟
ـ مدخل إلى: الشعور، الشعر، والشاعر:
إذا كانت الموهبة هبة من الله ـ وهي كذلك ـ، فالموهوب يقيناً هو الذي يفلح كتابة في ترجمة المألوف من المشاعر بصورة لا مألوفة. الموهوب هنا هو الشّاعر، واللا مألوف الكتابيّ هو الشّعر أو أي جنس من أجناس الأدب المتعارف على تصنيفها، بينما تقصّدنا كتابة المشاعر بشكلٍ كتابيٍّ، وحرفيٍّ؛ لأن المشاعر صفة جامعة، وموحّدة، في عموم عباد الله، وبحسب معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب لـ مجدي وهبه وكامل المهندس، فالشعور “consciousness” عند علماء النفس: يُطلق على العلم بما في النفس أو بما في البيئة وعلى ما يشتمل عليه العقل من إدراك ووجدان ونُزُوع. أما الشعر فهو: فـن من فنون الكلام يوحي عن طريق الإيقاع الصوتي واستعمال المجاز، بإدراك الحياة والأشياء إدراكاً لا يُوحي به النثر الإخباري. بينما كلمة الشاعر في اللغة العربية مشتقة من شَعَرَ بمعنى أحسنَ وعَلِمَ وإنما سُمِيَ كذلك لشدة فطنته ودقّة معرفته ورقّة شعوره.
ويكفي أن نعلمَ أن الشاعر عند الأوربيين كان يطلق على من يبدع عملاً فنيّاً ثم تحدّدَ المعنى ليدلَّ على من يبدع العمل الفنيّ عن طريق الكلام المنظوم. بينما ذهب فيكتور هوجو 1885 إلى أن الشاعر يعتبر بمثابة نبي يطلب منه أن يقودَ شعبه نحو الكمال.
1 ـ كيف تصنع كتاباً يحقق أعلى مبيعات؟*
بهذا العنوان اللا شعري، والغريب على حد سواء، يراهن الشاعر على وليمته الشعرية المتميّزة، المتميّزة فور الانتهاء من قراءة الديوان، لا لحظة التأمّل في عنوانه! فالعنوان كما أسلفنا سابقاً لا شعري بامتياز، فهل الشعر ـ والسؤال جائزـ صنعة مثلاً؟ وهل الشاعر يرتكب الشعر ليحقّق ديوانه أرباحاً قياسيّة فقط؟ وهل الشاعر يبيع مشاعره المرهفة؟!. المعادلة على هذا النحو غير متوازنة إطلاقاً، ملغومة، وتفتقد للمجاهيل، لأن الشاعر الحقّ ليس تاجراً أوّلاً، ولأنه ـ وهو يسهب في الحديث عن مشاعره ولواعجه ـ لا يبتغي ربحاً بقدر ما ينصّب من نفسه وقلمه سفيراً لتصدير الجَمَال ثانياً.
يولي أبو زيد الحسيّ، الهامشيّ، والإنسانيّ، أهمية تفوق تلك الأهمية التي يوليها غيره ممن يعلون من شأن الملتزم والخسارات العامّة والوطنيّة تحت بند القضايا الكبرى، هذا الأمر لا يعني أن شاعرنا لا يأبه بما يدور حوله من أحداث جِسام تشغل غيره، فأبي زيد الذي ينتصر للحرية والربيع والأشجار والعصافير والبتلات والزهور والأسماك والسينما والموسيقى والشموع ورائحة النعناع وماركيز وأحمد حامد وعبد القادر وغادة يسهب في الحديث عن خساراته الشخصيّة التي هي كلّ آماله وأحلامه، فيشير، ويقتصّ، بطريقته الشعرية، من أولئك الذين شوّهوا الحياة ، هو لا يشير إليهم فقط، بل يدينهم، دون أن يكبّد نفسه عناء التطرّق لذكرهم، لأن الشعر، وفي جانب جوهريّ منه، هو الذي يُكتب، ويرمي لشيء آخر تماماً:
“وصل الضيوف باكراً/ أيقظوا زهرة كنت أحبها/ وأفسدوها../ حتى عضلة الحزن البلاستيكية/ احرقوها /أيها النهر الصغير خلف الباب/ كن رجلاً واخرج إلى الغرباء/ واستعد لي حياتي”. قصيدة “حياتي”.
ولعل قصيدة “ناس” هي التي ستتكفّل، وبشكل جليٍّ، بتبيان ما ذهبنا إليه من مرام في هذا الباب، يقول: “الناس في الطابق الأعلى يطبخون القمر في عيون الكابوريا/ بينما الآخرون في البدروم يسحبون شرايينهم من الأفران/ يا ناري وليلي وعيني/ يا خطاباتي التي طارت إلى أين؟“
يخيّل للقارئ أن ما يقرأه من أشعار في هذا الديوان ليس إلا سرداً مشعرناً، وهو على نحو ما على حق في ذلك، فشاعرنا الذي اعترف بأن الحبّ أكثر أعداءه مكراً في قصيدته التي حملت عنوان الديوان يولي الحكاية اهتماماً يليق بها، هو يسرد حكايته، ويرشُّ عليها بهارات شعره، ثمّ يفلسف ذلك الشعر حتى يخيّل لنا إننا في حضرة شاعر كيميائي، تجريبي، مهووس بالخلطات، متأمّل وحكيم ومتمرّد على حد سواء، يتأمّل أبو زيد في مشهد حكائي، ثمّ يستخلص منه عبرته الشعرية، المطبوخة على نار هادئة، عبر سفر تأمّلي، أو رحلة تمرّدية، مبيّتة لها سابقاً: “أعتقد أن الأمواج كلمة غير جيدة/ استعملها كثيرون وفقدت ما أريده منها/ أريد الأمواج التي تتحول إلى بنزين/ أنظر إليها فتشتعل/ قديماً كنت أفعل هذا”. قصيدة “بنزين”. وهو بالضبط الأمر الذي يشتغل عليه الشاعر في عمله هذا، فهو آل على نفسه عدم تكرار، أو كتابة المألوف، الممجوج، القشور، السطحي، والتافه، ولأن أبو زيد يعلم تماماً ما ذهب إليه أبو تمّام من أن الشعر مطر يكاد الصحو ينبثق منه، أو صحو يتجلّى المطر في عيونه، فهو يسعى جاهداً لكتابة شعر خال من الزوائد والترهّلات والحشو الوصفي، كتابة شعر حارق، ومغاير، يغوي ويلسع، ينهمر مثل الشلال، شعر ينتصر في أُسّه العميق للمعنى والمثل العليا على حد سواء.
يزخر الديوان بقاموس من المفردات التي تؤدّي أغراضاً شعرية مختلفة تنصب في حقل دلالي واحد كما تنصب بالوقت ذاته في خدمة المعمار الشعري والفني لكلّ قصيدة من قصائد هذا الديوان، فالشاعر وهو يعرج على مفردات/ مواضيع من قبيل: الفقد والود والهجران والحنين والشوق والأمل والألم، وهو يشبع تلك المواضيع شرحاً ونبشاً، وهو يرشُّ عليها ماء الشعر، الشاعر وهو يفعل كلّ هذا، إنما يسعى ليكون حرّاً فقط، فهو يفهم الحرية ويستوعبها وينشدها، لأنها وحدها التي ستنتشله من البئر، حيث الظلام الدامس، وستجعله قادراً على الكلام، ليفضح من ثم المسكوت عنه.. يقول في ومضته حرية: “كثيراً ما يتوهج الحقل في ليلة كهذه… خرجنا من البئر…. وتكلمنا”.
ولأن الشك هو قدر الشاعر، ودليله إلى شاطئ اليقين، فهو قلق دوماً كأن الريح تحته، إنه يتعب، ييأس، يحبط، ويهذي، لكنه يسطّر في النهاية صوراً ورؤىً ومعانيَ شعرية تفوح منها رائحة النعناع، فلمن سيترك الشاعر ملعبه، ملعب الشعر؟: “لأن الأصل في اللعبة هو الشك/أقضم عود النعناع الذي ظهر فجأة في يدي/ وأغادر الملعب/لكن، لماذا هو الشك؟/ ولماذا يظهر النعناع فجأة؟!/تعبت.. والله تعبت”.قصيدة “اللعبة” .
وأمّا الملفت في هذا الديوان فهو سعي الشاعر الحثيث لارتكاب ومضات شعرية لن يستقيم معناها، أو لن تؤدّي الغرض المراد منها إلا بما يضيفه القارئ إليها من مقاطع، إضافات، وتخيّلات، على اعتباره ـ أي القارئ ـ شريكاً في المعادلة الإبداعية جنباً إلى جنب مع الشاعر ونصّه الشعري، نحن في هذا الديوان إزاء قصائد متنوّعة: الهايكو والبرقية والسريالية والقريبة من القصّة القصيرة جدّاً وقصيدة الرؤية، سيوظّفها أبو زيد بمهارة متقنة في خدمة القصيدة النثرية بنفس مصري رائق وأصيل.
سيعثر القارئ أيضاً في هذا الديوان على إجابات لأسئلة لم يقيّض له أن وجدها في متن شعري سابق إلا نادراً، وهذا الأمر ليس امتيازاً، لأن الأمر ذاته سيشكّل حيرة لقارئ آخر بعد أن يصطدم بأسئلة وجودية وأخلاقية وتجريبية غفل عنها تاريخه الطويل وهو يدأب بحرص على قراءة متون شعرية، ثمّة أيضاً قصائد مستغلقة في هذا الديوان، هي ليست مبهمة يقيناً، لكنها تندرج في خانة الغموض الشفيف، وشتّان ما بين الغموض والإبهام! وهذا الأمر سيشكّل بعض النفور لقارئ آخر، لأن أبو زيد يكتب بدهاء أيضاً، هو لا يسقط هذا القارئ من حساباته، لكنه يطلب منه أن يكون غوّاصاً ماهراً في بحر الشعر، أو قارئاً على قدر عال من الحساسية وفق ما ذهب إليه الأسلوبي جورج مونان الذي خلص للقول من أن هناك صوراً شعرية يستحيل كشف الجانب العميق فيها إذا لم نتأمّل فيها مليّاً أو إذا لم نقرأها بإحساس عميق.
2ـ أكلت ثلاث سمكات وغلبني النوم*:
عنوان الديوان من أهم نقاط قوّته وتماسكه، والعنوان هنا شعري بامتياز، وقد استلّه أبو زيد من مقطع في قصيدة هي من أطول قصائده، وحملت عنوان” أشياء صغيرة لأجلها أحبك ص 7″ ومما جاء فيها: “أحبكِ وأنا أحمل جيتاري المكسور/أحبك لأنني لا أجيد البرتغالية مثلاً/أحبك لأن يدي تؤلمني وأنا أتكلم/ ورقبتي تميل ناحية اليمين قليلاً/ كلميني وأنت في البلكونة/ أرسلي لي بعض الهواء/ أكلت ثلاث سمكات وغلبني النوم/ أحبك لأن اللغة العربية تقول إنني أحبك”.
يثير أبو زيد في هذا الديوان بعض الحالات، والقضايا الفلسفية، فلا يقف أمامها موقف المتفرّج، بل يشرحها، ويدينها إذا استدعى الأمر ذلك، فهو قد أحبَّ فتاة من غير دينه، تدعى جلوريا، عبر معها الصحراء، وطلب من الرّب أن يباركه، كما أنه الشخص السابع في العائلة الذي مات، ولا يزال على قيد الحياة، واختفى فجأة من المرايا، ولم تعد الحيطان تمنعه من المرور عِبرها، وهرباً من شيء عظيم يلوذ بالعاهرة، يضع وردة حمراء في صحن أبيض، ويقدّمها لها، ويبكي على صدرها إذ تضمّه.
كما أنه لا يكتب شعراً صاخباً لأنه يعي تماماً أن قوّة شعره تكمن في بساطته المنثالة، وشَاهِدُنا على ذلك ما كتبه في مقطوعته “مكسور” ص 61، وقصيدة موسومة بـ “بسيط” ص 55: “أنا العامل البسيط عند أبي وأمي، أسقي الزروع وأجلب للطير رزقاً”.
تلكم هي المداميك التي تجعل مما يكتبه أبو زيد كتابة متميّزة، شاعر مغرم بالجدة والخلق والابتكار والنحت والرسم والتمثيل والموسيقى، ومسكون برفض المسلّمات واليقينيات، شاعر مهووس بالحبّ والورد والرقص والجمال والدفقة الشعرية المركّزة، لا يكتب شعرا فائضاً، عبثياً، بل يسرد حكاية تنطوي على شحنة شعرية كبيرة كما في قطعته الشعرية الباذخة” أوصاني أبوك يا زبيدة ص 25″، والتي يقول فيها:
“أوصاني أبوك يا زبيدة أن اشتري لك البحر مع البيوت القريبة الملونة/ وقال لي لا تعد إلى البيت قبل أن تودع الصخرة والشجرة والكلب الناعس العجوز/ وكن لطيفاً مع الحصان لأن ساقه تحطمت تحت عجلات عربة غادرة/ واسأل صانع الصحون الخوص هل عادت زوجته إلى كتابة الشعر ثانية/ هذه المرأة ليست من بلادنا لكنها تكتب الكلام في هيئة غريبة…”.
إذا كان الشعر هو معنى المعنى وفق ما ذهب إليه بلاكمور في مقاله “اللغة من حيث هي إشارات” فالقطعة الشعرية في “أكلت ثلاث سمكات وغلبني النوم” هي شعر الشعر، الشعر القائم على الفكرة الشعرية، والحكاية الشعرية، بمفردات، أو كلمات، لا شعرية غالباً.
3ـ الحياة السريّة للمجنون الأخضر*:
يواصلُ الشاعر في هذا الديوان استغواره الشّعريّ، المُغَامِر، والمائز، فيحتفي بالحبّ احتفاءً شعريّاً باذخاً، يُوُلِمُ له، يجوّد، ويصطفي، يضيف، ويجدّد، ويُكرّس له العمل برّمته، أشعار هذا الديوان عبارة عن فلاشات ومقاطع ولوحات وبرقيات، وفيها ما فيها من روح الومضة حيث المفارقة الإشعاعيّة، أو القفلة الصادمة، ومثالنا هنا قصيدة “عربات” التي يقول فيها:
“اليوم عادت كلّ العربات محطمة/ وعاد حصانها الوحيد يلهث”. ص 53
وثمّة قصائد تندرج في حقل القصّة القصيرة جدّاً، أو القصيدة الحكائيّة، ومثالنا هنا قصيدة “حديقة” التي يقول فيها:
“في حديقة المشاعر الرقيقة هبط الملاك قبل ساعتين/ وجدني نائماً قرب غصن النعناع المائل المكسور/ سألني هل تريد شيئاً من عينيها/ قلتُ: من هي؟/ قال: حبيبتك/ قلتُ: ما لي حبيبة يا ملاك/ قال: بل هي هنا./ وأشار إلى ضلوعي/ فتألمتُ/ وبكيتُ”. ص 63
ثمّة أيضاً قصائدَ عبارة عن مقاطع غنائيّة صغيرة ومثالنا هنا قصيدة “الذي” التي يقول فيها:
“المطر الذي يتجدّد مع الذكريات/ العزف في الليل على الكمنجات/ رحلة الصيد في القوارب الصغيرة/ والصخور في البدايات والنهايات”. ص 71
وتبلغ الشعرية ذروتها في قصائد “ميوزك وذكرياتي وساسو” إذ إنها تقترب من الشعرية السحرية حيث الإدهاش والتخييل والفضاء المفتوح على التأويلات.
يندر أن يتعثّرَ القارئ في شعر أبو زيد الشذري على صورة شعريّة صرفة في هذا الديوان لأنّهُ يعوّل كما أسلفنا في عمليه السابقين على الحكاية الشّعريّة، أو الشّعريّة الساردة، كما لو كان قاصّاً، ويعوّل بالمقدار ذاته على القطعة ككل، إذ تشكّل الحكاية بالنسبة له الشرارة الأولى، أو المخطّط البنائيّ والعمرانيّ لتوجيه بوصلته صوب قصيدة أو قطعة فنيّة تتوافر على جُلّ مقومات القصيدة الشّعريّة والشّعوريّة على حدٍّ سواء على اعتبارها ـ أي الحكاية ـ جوهر العمليّة الإبداعيّة، شعراً كان أم قصّةً، مسرحاً كان أم روايةً، وعليه .. فهو يدبّج قصائدَ ترشح شعرية فور الانتهاء من قراءتها، وهذا الأمر ليس سهلاً كما قد يتصوّر البعض، بل ليس في متناول الجميع ـ نقصد أترابه من الشعراء ـ، لأنّهُ في الوقت الذي ينصرف فيه إلى إسباغ الشعريّة على الوحدة العضويّة والهيكيلية لعموم ومفاصل قصيدته ينهمّ نفرٌ من الشّعراء بالتورية والاستعارة والرمز والإبهام فتكون ثمّة صورة شعريّة حلوة لكن في قصيدة مالحة.. متصحّرة. فهو، والحال هذه، يقوم بوظيفة على غاية من الجودة والحذف والسبك والإضافة والتجويد والإتقان، إنّهُ صيّاد القفلة واللحظة الشعرية الحالمة والمستفزّة والرقيقة والصادمة، إذ يعي تماماً كيف تُكسى المشاعر، وكيف تؤثث، يخلط ـ ككيميائي ـ الألوان والتأثيرات والمؤثّرات والمتفاعلات والمنصهرات من أنصاف وأثلاث وأرباع الصور والمفردات في مختبره الشّعريّ ليجدَ القارئ نفسه أمام صورٍ وجُمَلٍ قوس قزحية ناطقة ومبهجة.
بالرغم من أن المجنون الأخضر يعي أنّ صانعَ قصّص الحبّ هو أول ضحاياه، فهو يرفع من شأنه، لأنّهُ يرى أنّ الحبّ هو الأبقى، وأنّ الجواسيس والخونة والسكارى وكلاب الحراسة والوغد الكبير الذي يحكم المدينة لا محل لهم من الإعراب في معادلة الحوار والبناء والحرية والعيش الكريم، وبحسبه.. فالحبّ هو الحل الوحيد والأمثل لاجتثاث الكره والبغض والأحقاد. الحبّ في عرف المجنون الأخضر لونه أخضر، حتّى في الخريف لونه أخضر، فلا تروق له أنصاف الحلول في المحبّة، فهو إما أن يكونَ عاشقا بكلّ جوارحه، وإما أن يكونَ معشوقاً. الحبّ قِبلة المجنون الأخضر، أوجاع الحب عنده تظهر حتّى في يديه، دمّه، ونبضه، بلا حبٍّ لا تستقيم أحواله، تراه محموماً، وما هو بمحموم، مسافراً، وما هو بمسافر، مخاصماً، وما هو بمخاصم، مطارداً، وما هو بمطارد، مجنوناً، وما هو بمجنون.. وقَلِقٌ كأنّ الريحَ تحته. يحلّق المجنون الأخضر في فيافي الحبّ وأمداءه، يجوب المحيطات، ويركب البحار؛ لأنّه لا يستطيع أن يعيشَ، أو أن يتنفّسَ، دون أن يُحِبَّ، أو يُحَبَّ. يكتب المجنون الأخضر رسائل الغرام، يسعى لتأليفِ كتابٍ عن القُبلة، يعيش بنصف عقل بعد أن سلبه الحبّ النصف الآخر، يرقص على أنغام الغيرة واللوعة والفراق الهادر العنيف، يحبُّ الحياة، ويستمتع بجنونه، يمشي، ولا يكبّد نفسه عناء إلقاء نظرة خلفه، يمضي قدماً، بل لا يتورّع حفيد ابن عربي، ومعاصر نزار قباني، عن الاعتراف بالحبَّ مذهباً، ومسلكاً، والدعوة ـ من ثمّ ـ لتأسيسِ جمهوريّةٍ شعارها الأوحد هو الحبّ قولاً وفعلاً، إنّه يغنّي ويموسق ويدبّج، يعيد صياغة الجمال، ويردّد، وهو يزقزق حبّاَ:
“أدين بدين الحب أنّى توجهت ركا / ئبه فالحب ديني وإيماني”.
ـ أحلام مورجان فريمان*:4
عالج فرويد في كتابهِ “تفسير الأحلام” الصراع النفسيّ بين الرغبات اللاشعوريّة المكبوتة، والمقاومة النفسيّة التي تسعى جاهدةً لكبتِ تلك الرغبات، لِيخلصَ إلى اِعتبارِ الحلم بذاته حلّاً وسطاً، أو حلّاً توفيقيّاً بين تلك الرغبات المُتصارعة. الحلم ـ بحسبه ـ يعمل على عدم اقلاق النائم، أو ايقاظه، فإذا ما أحسَّ النائم بالعطش مثلاً، قد ينهلُ في الحلمِ حتّى يرتوي، وبذلك لنْ يضطرَ للاستيقاظ لِيشربَ ماءً. أمّا الفريد أدلر فيرى أنَّ للحلمِ وظيفة تنحصرُ في توقّع ما يمكن أنْ نواجهَهُ من أحداث في المستقبل، بينما ذهب كارل يونغ إلى أنَّ الأحلامَ قد تكون سبّباً في إيجادِ حلولٍ لمشاكلَ يعاني منها النائم؛ بهدف عودة ما تيسّرَ من التوازن إلى شخصيته. وأمّا الأحلام من حيث الّلغة فهي:” الأحلام جمع حُلْم بضمِّ الحاء وتسكين اللام ويجوز ضمّها، فيقال: الحُلَم مشتق من حَلَم حُلْماً ومعناه من رأى في نومه رؤيا”. وقد وردت كلمة الأحلام في القرآن في آيتين، وهما:” وقَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِين”يوسف 44، و”قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ” الانبياء 5.
لم تكن أحلام مورجان فريمان في فيلم”فتاة المليون دولار” الفائز بجائزة الأوسكار أحلاماً بقدر ما كانت مُتَمَنَّيَات، أسندَ إليه كلينت إيستوود دور مساعد مدرّب، وقد تخرّجَ على قبضةِ العاشق للحَلَبَةِ ما لا يحصى من الملاكمين الذين فازوا واشتهروا بفضل تدريبه لهم وتوجّهاته، لكنَّهم كانوا ينكرون فضله. كان يطمح لأنْ يكونَ مُدرِّباً مُستقلّاً بذاته، وأنْ يقدّرَ حقَّ قدره، وكان يعمل بكلِّ ما أوتيَ مِنْ جَلَدٍ ومِنْ تدريبٍ كي تحرزَ هيلاري سوانك، الهاوية، والمُدججة بالطموح والغضب لَقَبَاً يعوّضها عمّا عاشته ورأته مِنْ ألمٍ ومِنْ معاناة، لكنّها في دربها المحفوف بالاحترافِ كانت قد تعدّتِ الثلاثين من عمرِها، وهو سنّ اليأس في العرف الرياضيّ. طموح عصام أبو زيد في تحفتهِ الحلميّة ” أحلام مورجان فريمان” لا يقلُّ عن طموح ماغي، هو أيضاً بحاجةٍ لمنْ ينيرَ دربَ شِعره، ويفجّرَ الغضب بداخله، وليس أصلحَ ـ ولو على سبيل حلمٍ ـ من مورجان فريمان لهذه المهمة: “كنا .. أنا ومورجان فريمان/ في نفس السيارة القديمة/ المخصصة لنقل الأحلام/ بين القرى والمدن./ كان مورجان يتكلم عن فيلمه الشهير/” فتاة المليون دولار”/ بينما أنا أفكر في بقعة الضوء فوق حذائي/ بقعة غريبة لا تتحرك أو تتزحزح عن مكانها/ وكأنها التصقت بالحذاء/ حاولت كثيراً أن أغيّر مكاني ـ في السيارة ـ من مقعد إلى آخر/ حاولت.. ولكن بدون جدوى/ وظل مورجان يتابعني غاضباً بعينيه/ بينما البقعة في مكانها ترفض أن تغادر/ لا أتذكر متى وصلنا إلى الشارع الأزرق/ ـ نسيت أن أقول إننا كنا في طريقنا إلى الشارع الأزرق ـ / أتذكر أن مورجان سبقني واخترق قلب الزحام/ بينما أنا بقيت أراقب بقعة الضوء فوق حذائي/ وأبتسم… في خبث”.
يرتكب الشاعر هنا قصيدة تأمّليّة ـ تنتزع من قارئها التأمّل ـ، وتصويريّة ـ مشهديّة/سورياليّة ـ تتصدّى لطرحِ الحكاية بطريقةٍ فيها من الشِعرِ ما فيها، وفيها من الجنون المُبتكر ما فيها، إذْ يطلق العِنان لحصانِ خياله المتقد في اِجتراح أحلامٍ على شكلِ متاهاتٍ، بحيث تفضي كلّ متاهةٍ إلى أخرى، وتتوالى بذلك سلسلة أحلامه الغرائبيّة والسحريّة.
كلّ شيءٍ يضيء في هذا الديوان، الأحاسيس الرماديّة تضيء، النجمة السوداء تضيء، الحذاء يضيء، كما أنَّ الذئابَ تبيض، والسيّارة مصنوعة بالكامل من خشب الأبنوس، وتصل أحلامه ذروتها عندما يخبرنا أنَّ سيّارته الفيراري نصفها من بسكويت، ونصفها الآخر من عصائر مجفّفة. وفي أحلامه سكّان المدينة الساحليّة يمتلكون طائرات ورقيّة كبيرة، ويستخدمون أجنحة تلك الطائرات كمظلّات، النجوم الصغيرة في أحلامه تتحدّث كما قطّته الناضجة التي بات لديها رغبة كبيرة في البوح، ومن أحلامه ما تخبره به الحبيبة من أنّها ستمضي ليلتها في بيت والديها، لا توجد حول البيت حديقة، لكنّها تؤكّد لحبيبها أنّه قادرٌ على احضارها. عند الشاعر ثمّة كواكب من ثلج، وكواكب من ورد، وكواكب من بيتزا، كما ثمّة سماء من الفلفل الأحمر، وثمّة حمار عجوز يرتدي قبعة كاوبوي، ويدخّن طوال الوقت. الشاعر لا يتورّع عن تشبيه العسل بالعجوز، والأكتاف العريضة بحاملات طائرات، إنَّهُ يحلم دائماً: يحلم وهو في العمل، يحلم وهو يقود السيّارة، يحلم وهو يحطّم سيّارة جارته؛ لأنَّ كلّ شيءٍ ممكن في أحلامه، حتّى أنّه يمكن لحبيبته أنْ ترسمَ اسمها فوق لسانه. يقول: “توجد رسالة مغلقة/ في مكان ما/ ولن أبحث عنها/ أعرف أن الأحلام/ لا تدوم”.
ويرى الشاعر أنّ الاستماعَ إلى أغنيات عبادي الجوهر لا يحتاج إلى مقبّلات؛ لأنَّ أغانيه بالنسبة إليه وجبة دسمة، كما أنَّ قطّته تحبّ أنْ تسمعَ أغنية fever بصوت بيجي لي، تسمعها وهي تحتضن صورة لسمكة كبيرة، وأنّه عندما كان صغيراً كانت المجموعة الشمسيّة لا تزيد عن كوكبين، وكانت الأمطار تسقط إلى أعلى. الشاعر يطلب من مُلهمته أنْ تعملَ في حديقة أحلامه كأخصائيّة في عواطف الزهور، ولأنَّ زهرة السوسن تحديداً تنمو فوق كتفها، فهي المرشّحة المثالية لمنصب رئيسّ مجلس الإدارة. يقول:” شفتاي اليوم في الصيانة، ولا يمكنني الآن تقبيلك”، لكنّه يقترح عليها أنْ تذهبَ أوّلاً لمتجر الألعاب الناريّة؛ لتشتري منه قنبلة صوتية، ويقترح من ثمّ أنّ تذهبَ إلى متجر التوابل؛ لتنتزعَ باب المتجر الساخن، ثمّ يقترح عليها أخيراً أنْ تذهبَ إلى متجر الأسطوانات القديمة؛ لتشتري أغنية لجوني كاش، إلى أنْ يطلبَ منها في النهايةِ أنْ تطحنَ الجميع بين ورقتين، وأنْ تحرصَ على إضافة القليل من ماء الورد، وعصير التوت، والعنب، لتحصلَ في المُجتبى على المزيج المثاليّ لنكهة شفتيه.
يدرك الشاعر جيّداً أنَّ الاشتغالَ الشِعريّ لم يعد مقتصراً على تدبيج قصيدةٍ سليمةٍ من الناحيةِ الّلغويّة، وتحكي حكاية، وبالتالي تأثيث فضائها العامّ بالبديع من التراكيب والتوريات والصور، نحن هنا أمام اِشتغالٍ شِعريٍّ مُختلفٍ، يستحلبُ اللا مألوف، يستنطقهُ، ويستشعرهُ، بَلَغَ فيه التجريب المفتوح على التخييل والأمداء والأسئلة ذروته ومنتهاه، إنَّهُ التجريب العجائبيّ الذي يُعَلّْمُ على القارئ، فيتشارك بمحض إرادته مع الشاعر في عملية الشِعر الإبداعيّة، ويضطرُ بالتالي لإشغالِ ذهنه مع مقترحاته الجماليّة والأسلوبيّة والشِعريّة، وبذلك نكون أمام تجريبٍ خلّاقٍ ينأى بأدواته ومقترحاته عن استغباءِ القارئ والتغريب المقيت والصنميّة والاستعلاء أو الانتفاخ البالونيّ. لا عناوين فرعيّة، أو داخليّة بين دفتي الديوان، هل للأحلام عناوين!؟، ربّما، لكنّها هنا ليست سوى مقتطفات بدون عناوين، مقتطفات حلميّة، مصبوبة أحياناً، ومجتزأة أحياناً أخرى، اكتفى فيها الشاعر بالعنوان الرئيسّ على الغلاف. الأحلام فقرات هذه المجموعة، وهيكلها الشِعريّ، التتر، والموسيقى التصويريّة المُصاحِبة للإيقاع المفرداتي والجُمَليّ، عبر سكب لوحات، أو رسائل شِعريّة، حِواريّة، مونولوغية، استعادية، بين ذاتين ساردتين، عبثيتين، وحلميتين، يتحكّم بهما الذات الشاعرة: هي تسرد حلماً، وهو يسرد حلماً آخر، هي تسأل، وهو يجيب. يقول: ؤ
“ماذا تفعلينَ عند بائعِ ملابسٍ الغطس؟/ النجومُ الصغيرةُ في قاعِ المحيطِ/ لا ترغبُ في الحديثِ معك/ والأخطبوط الأرعنُ ـ قاتلُ أبيه وأمه ـ/ لن يعودَ إليك/ أنتِ أحدُ أسبابِ الشرِّ/ في عالمِ الأعماق”. ويقول أيضاً: “اتصلت عليك لكن البيانو كان مغلقاً، كلمتني الموسيقى وقالت إنّك مشغولة، وأخبرني الماء أنَّ البيتَ مهجور”.
………………………………………………………
 مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.
مجلة قلم رصاص الثقافية رهان أخير على دور الفكر الحر والمسؤول في إعادة بناء الوعي واستعادة منظومة القيم، "على قلم وساق" من أجل ثقافة هدفها الإنسان.